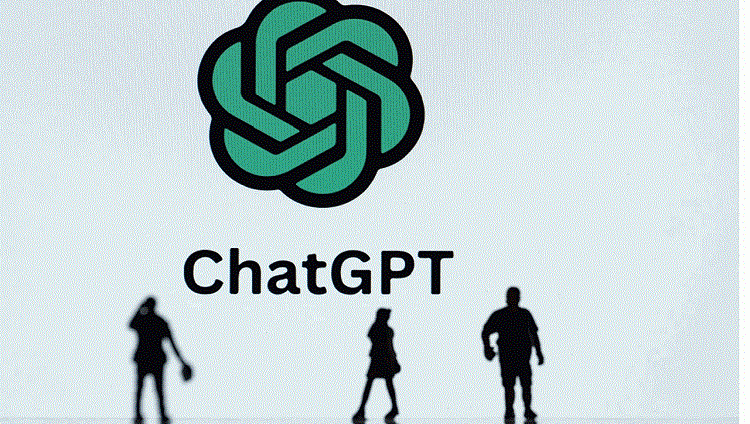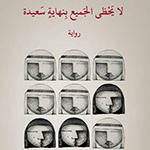
الكاتب محمد خميِس بروايته الجديدة “لا يحظى الجميع بنهاية سعيدة” الصادرة حديثاً عن دار “كُتّاب” للنشر والتوزيع، يقدم نموذجاً مختلفاً عن السائد والمألوف في السرديات الإماراتية والعربية الكلاسيكية أو المعاصرة. ويمكن إعتبارها مغامرة روائية تجريبية بامتياز، إذ لا ينحصر وجه الاختلاف أو المغايرة على المستوى الفني، سواء لجهة أسلوب السرد وتكنيك التداعي والحبكة الأدبية، أو لجهة بناء الشخصيات في اللعبة الروائية وتطورها بما يتماهى مع الوقائع أو الأحداث، وإنما يتعداها إلى شكل الحكاية، التي تبدو في سياق النص وكأنها حكاية فانتازية تتمظهر بالوقوف على التخوم ما بين الخيال والواقع، بالحدود الصارمة التي تستجيب للشرط الأول في الفن الروائي. ولكنها في الحقيقة هي حكاية فانتازية مغرقة برومانسيتها التخييلية وتداعياتها المبسطة التي تقارب السذاجة ببراءتها، وتلامس مسرح العبث بهذيانها، أو الكوميديا الباكية الضحوك بسوداويتها، وفي الوقت عينه، هي حكاية مثقلة بالرموز والدلالات والإشارات الكاشفة، المتوهجة، الساطعة، التي تحيل الذهن إلى الواقع بمنتهى الصدق العاري، الذي لا يقبل التأويل أو التضليل، بل تحيله إلى قلب الواقع كما هو بكل فجاجته وقسوته، بكل مرارته وإخفاقاته وبكل إنكساراته وارتداداته، ما يصفع الوعي ويعيده إلى مواجهة الحقيقة المؤلمة، التي تهز الناموس وتجرح الوجدان وتغور عميقاً في الذات، عندما تصبح الذات وحيدةً بمواجهة خيباتها واحباطاتها من دون أدنى رتوش أو تزييف.
مرواغات فنية
تقوم اللعبة الروائية بالنص على جملة من المخاتلات أو المراوغات الفنية الشائقة، تجعله يبدو وكأنه مكتوب ب”طلقة نفس واحدة”، – إن صح التعبير – رواها حكواتي واحد، متمرس بالحكي، بل محترف بفنون الروي أو السرد، راوية متمكن من ضبط إيقاع الكلام أو نبرات الحكي، التي تصعد بالأحداث إلى قمة الذروة حيناً، وتنحدر بها إلى حافة الهاوية حيناً آخر. ما يُحتم قراءة النص ب”طلقة نفس واحدة”. فعلى المستوى الزماني – بالنسبة إلى وقائع أو مجريات الأحداث وعصر الشخصيات-، يفاجئنا الكاتب بزمن أكثر من واقعي، بل هو معيوش يومي في العصر الراهن لحظة بلحظة، وربما يسكن الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه والغذاء الذي نقتات به. أما على المستوى المكاني فيصر الكاتب في تصديره للنص على أن “كل وقائع، وشخصيات، وأسماء المناطق، والبلدان في هذه القصة حقيقية”. وبالمقابل يُصِرُّ الراوي (البطل) منذ الصفحة الأولى على أنه مكان إفتراضي متخيل، ولكنه يمكن أن يكون مدركاً ومحسوساً، وربما ملموساً بكل حيثياته أو تفاصيله دون أدنى لَبْس. حسبما يقول الرواي: “أدعى إبراهيم مطر، أنتمي إلى مملكة جزيرة الروضة، وهي إحدى ممالك الجزر الأربع، تقع في خليج عمان، لها جسر يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وآخر بسلطنة عمان، ونفق بحري طويل يربطها بكل من قطر والبحرين. ترتيبي السابع بين أحد عشر أخاً، سبعة أولاد وأربع بنات”. فالرمزية الجغرافية التي يستخدمها الكاتب لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، فهي تتجاوز بدلالاتها محاولة الإضاءة عن بعد، إلى حدود الكشف الذي يملأ البصر ويفيض على اليقين. كما هو شأن الرموز الأخرى المتعددة في النص، مثل إطلاق إسم “الديرانيين” على قوات الإحتلال المتخيلة، و”مملكة الجزيرة الكبرى” للإشارة إلى أكبر دول المنطقة، و”مملكة جزيرة المرجان”، و”مملكة جزيرة الجزيرتان”، وبلاد “الكنانة”، و”الجمهورية الشامية”، والبلاد “الخضراء”، أو”السعيدة”، وغيرها الكثير من الرموز الموازية، للدلالة على الموضوعات الثقافية بكل المستويات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والسياسية.
بناء الشخصيات
أما بخصوص مسألة البناء الدرامي للشخصيات، التي يفترض أن تتدرج في الرواية، بما يتناسب مع تصاعد الأحداث وتشابك المواقف في سياقاتها الصراعية أو القدرية، فنجد أن الكاتب يلجأ إلى أسلوب غير معهود في الفن الروائي، حيث يَتقصَّد منذ الصفحة الثانية بالنص، تقديم رسم محدد وتعريف دقيق لمعظم شخصيات الرواية الرئيسية، الذين هم أسرة البطل، (باستثناء أحمد ووالده وسيف ووالده وحصة). فالشقيق الأكبر محمد “كان أبينا الصغير، مسؤولنا الرؤوف، عمنا الكريم”، يليه سالم “إخونجي”، بينماعبدالله ليبرالي، وهما على طرفي نقيض طالما التقيا، والرابع في قائمة الأخوة، إبراهيم مطر (البطل- الراوي) هو “خلطة” من الجُبن والنذالة والأنانية المعجونة بالرومانسية والشفافية المرهفة، بنكهات إنسانية تتلاطم فيها المواقف بين مد وجزر دائمين، أما غانم فاستقل بزوجته وانبتر عن الأسرة، وحميد فهو مبتلى بلوثة عقلية. في حين أن وليد آخر العنقود كان يعيش حياة مختلفة بسبب صداقته مع أحد أبناء أعيان المملكة، وعندما اختطفه الموت ضربته الكآبة واتجه إلى المخدرات التي لم يصح منها إلا بالحرب. أما البنات ياسمين ونادين ورقية وخولة فهن متساويات بالتهميش والإستلاب في المجتمع البطريركي الأبوي، ومع ذلك لكل منهن شخصية متفاوتة عن الأخرى لجهة التعبير عن ذاواتهن وإختياراتهن، لذلك شاركن بالعمل والحب والزواج والمقاومة بمقدار تمايزاتهن، وواجهن أقدارهن بشجاعة لاتقل بطولة عن الرجال، حتى نادين التي سبق وأرغمت على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاماً، لأنه “مريّش” والمستقبل معه مضمون، من دون نأمة من إمتعاض أو رفض واحتجاج، إلا أنها رفضت الهرب والإلتحاق بالزوج، وقامت بدورها الوطني واستشهدت كما يليق بالأبطال.
السرد المستميت
أيضاً من جملة المخاتلات الفنية الماكرة، التي يلجأ إليها الكاتب، ويمارسها بحذاقة تنطوي على قدر كبير من الإقناع، ما يتعلق منها بأسلوب السرد، الذي بدى متدفقاً بعفوية متناهية، بحيث بدى الراوي، وكأنه يستميت بصدقه وسرده، الذي لم يقطعه سوى الأيمان المغلّظة، التي يقطعها للمتلقي، بأن كل ما يرويه هو الصدق الخالص، والحقيقة التي لا يداخلها شك من أمامها أو من ورائها، حتى في أكثر لحظات السرد فانتازية، وبعداً عن الواقع، أو في تشديده بأن ما يهمه من القصة، هو انتم، و”سوف أطلعكم في البداية كيف أتتني فكرة كتابة هذه الرواية، لن أسميها رواية، حتى لا تدرجوني ضمن أولئك النخبة، ولن أخاطبكم بلغة فوقية، هي قصة لكم أنتم، وأتمنى أن لا تقرأها النخبة، بل أتمنى أن يرموها في سلة المهملات، ويتجاهلوها، ويتكبرون عليها كعادتهم، أتمنى أن تقتلهم ركاكتها، ويصيبهم الملل من وقع أحداثها، لا يهمونني، من يهمني هو أنتم ولا أحد سواكم”. وهي مخاتلة بارعة تنطوي على بعدين من الاستدراج والتشويق:
– البعد الأول يستدرج المتلقي لمشاركة الراوي غضبه، وضيقه بالحقيقة التي تفقأ العيون، ومع ذلك تصر النخبة على تجاهلها وعدم رؤيتها. لذلك تستثنيها الكتابة، أو السرد، من التلقي، وتنحاز إلى البسطاء من الناس العاديين. وهي محاولة ذكية تؤسس بداية للتفريق بين فسطاطين من المتلقين، الأول يضم النخبة، وهم أقلية لأنهم من أهل الصفوة، بينما الفسطاط الآخر يستقطب البقية الباقية من المتلقين، الذين تمايزت عنهم النخبة، وتعالت عليهم بخطابها الثقافي. وهو أمر – أي التعالي أو الإنفصام- ملحوظ بقوة من قبل الجميع ما عدا النخبة عينها.
– البعد الثاني يستدرج المتلقي لغواية السرد وفتنة البساطة، إذ عندما تعلن الكتابة إنحيازها للأغلبية من البسطاء والعاديين من الناس، فهذا يستدعي إنحيازهم التلقائي لها والإنغماس بلعبتها أو الإنقياد لموجتها. ما يجعل الكتابة أو السرد أقرب من حديث المجالس، التي غالباً ما تتميز بالدفء والحميمية، وتتيح للنفس أن تفور بلواعجها كما ينبغي، من دون كوابح أو مصدات، وبالتالي يمكن للسرد أن يدفع المتلقي للتماهي مع الراوي ومشاركته اللهاث وراء الأحداث من دون فرصة للإلتقاط الأنفاس.
ولكن من ضمن المخاتلات الفنية التي أصابت أهدافها التجريبية بمهارة عالية في كل مراميها السردية والأسلوبية والبنائية والشكلية، لا بد من الإشارة إلى إخفاقها عندما تَقَصَّدَت “مطحنة اللغة” بسياق ما سميناه إنحياز الكتابة للناس العاديين، ولم يكن ذلك مبرراً أو مفهوماً على الإطلاق، ولا يجوز أن يكون بأي حال من الأحوال تهشيم اللغة أمراً مقبولاً تحت أي مرمى، وهذا ما أصاب لغة السرد بمقتل، وجعل وهجها التجريبي يخفت قليلاً، ولو أن الكاتب تجاوزها، – نرجو أن يفعل ذلك في الطبعة الثانية – لأكتملت شروط المغامرة التجريبية بامتياز مع مرتبة الشرف، ولأقتربت الرواية من الجوائز الكبيرة والقيمة، أكثر مما يُتوقع أو يُظن.
أسرة مستورة
الرواية تحكي قصة إبراهيم مطر وعائلته، باعتبارها أسرة مستورة، فالجميع يعملون ويعيشون في منزل صغير متهالك. الأب بواب مدرسة ابتدائية، قضى سنوات عمره ينتظر قطعة أرض وإعانة حكومية، لينتقل بأسرته إلى بيت أوسع، ولكنها لم تأت بحياته. لذلك عندما تزوج محمد الأخ الأكبر، الذي ترك التعليم والتحق بجيش الحكومة طوعاً، لمؤازرة الوالد بأعباء المعيشة، لم تحتمل زوجته الحياة مع أسرته بعلبة سردين، فكان الطلاق بعد سبعة شهور. وعندما جاءت الموافقة على منحة الأرض والإعانة، لم يتمكن الأخوة الكبار من استلام سند الملكية، لأن “جيش الجمهورية الإسلامية الديرانية” اجتاح البلاد، إثر قيام إسرائيل بقصف مفاعلاتها النووية، فوقعت الحرب وانجرت إليها أميركا، ما أرغمهم على الإستدارة بسيارتهم هرباً من حاجز لقوات العدو، ولكنهم ما إن وصلوا المنزل، حتى داهمه جنديان “ديرانيان”، بحثاً عنهم بغطرسة المحتلين، التي أربكت وأفزعت الجميع، ما دفع خولة لإستخدام مسدس ابراهيم وقتل أحد الجنديين وإصابة الآخر. وهكذا وجد الأخوة أنفسهم مجتمعين في إطارٍ مقاومٍ للاحتلال من دون تخطيط مسبق، رغم إختلاف الأهواء السياسية والميول الفكرية فيما بينهم. وبعد تداول بالأمر غادر الجميع المنزل، ملتحقين باسرة أحمد صديق عبدالله، المصنف من الدرجة الثانية بالتجنيس، فاستقبلهم أبو أحمد بحميمية مدهشة، حيث وضع كل علاقاته وخبراته وثروته الطائلة بتصرفهم في إطار جهدهم المقاوم، بعد أن ضم إليهم ولده الوحيد أحمد، وصار هو الرأس المخطط والمدبر للعمليات ضد الإحتلال. وانضمت إليهم حصة معشوقة ابراهيم المحرمة، التي طلب منه زوجها سيف، رئيسه النقيب في الشرطة أن يضمها لشقيقاته، لأنه مشغول بأمور هامة، ويتضح لاحقاً أنه مهتم بإخفاء والده المطلوب رأسه من الأميركيين و”الديرانيين” على حد سواء. وفي “فيللا” أبو أحمد تم توزيعهم إلى خليتين مقاومتين، تنشطان في المواجهة، فسالت الدماء، وتطايرت الأشلاء، وأنتُهكت الأعراض، وضاع الأحبة، ولم تنجو من محرقة الحرب حتى خولة، التي لا تعرف من الدنيا سوى الدهشة وكتابة اليوميات.
تحطيم النواميس
تنفتح الرواية على مسارات متعددة، تتقاطع فيها الأقدار الفائقة بغرائبية تستعصي على التصور، بحيث تصل الأحداث في بعض المواقف إلى ما يتجاوز حدود المنطق، وخاصة عندما يُقدِم الابن على قتل الأب، بعدما ظن أنه يتعامل مع الإحتلال، لأنه شاهده يتلقى مظروفاُ من أحد الضباط “الديرانيين” ويعطيه بدوره مظروفاً آخر، وقطع الشك باليقين بعد أن داهمت قوة للإحتلال بقيادة الضابط بهرام، الذي كان والده يحذرهم منه، وأعتقلت نواة المقاومة بما فيها البنات، وأخذت تسأل عن البطل إبراهيم مطر بالإسم، بحثاً عن أبي سيف الذي لا يعرف مكانه أحد سوى الابن القاتل والأب القتيل وإبراهيم المطلوب وشقيقه سالم، ليكتشف لاحقاً أن والده كان يشتري المعلومات من الضابط “الديراني”، وأن العميل هو سالم “الإخوانجي”، الذي تلاقى مشروعه الإسلاموي مع “الديرانيين” لإقامة دولة الخلافة، ففشى لهم بالسر. ومع ذلك تبقى المفارقات على قسوتها ولا عقلانيتها مقبولة في سياق عرض تداعيات ومفاجآت الحرب، التي من طبيعتها تحطيم نواميس المنطق والعقل. وهي مفارقات دفع بها الكاتب إلى ذرى من الغرائبية والتشويق والإثارة المفرطة، تتمازج فيها العواطف الشخصية بالإنتماء الوطني، مع النزعات الإنسانية، بخيرها وشرها، بقوتها وضعفها، في صراع عنيف لا يخلو من الصدمات التي تثير الدهشة والمتعة في آن واحد.
المصدر:محمد وردي – إيلاف