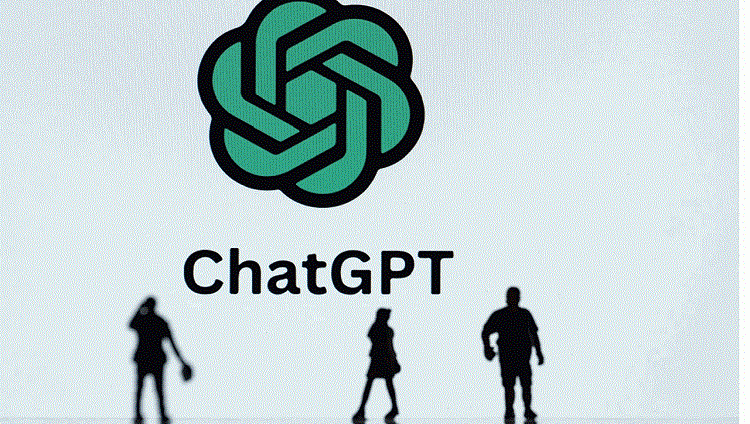أبوظبي: محمد رُضا
انطلقت الدورة السابعة لمهرجان أبوظبي السينمائي مساء يوم الخميس (الرابع والعشرين من الشهر الحالي) حاملة للجمهور وعودا متجددة بدورة توفّر لهم الجديد والجيد مقبلة من 51 بلدا. الرقم الإجمالي لما هو معروض في هذه الدورة من أفلام طويلة وقصيرة وروائية وتسجيلية يصل إلى 166 فيلما.
عادة ما يقيس بعض النقاد العرب بعض ملاحظاتهم على المهرجانات بكمّ الأفلام التي لم يروها من قبل، فإذا ارتفعت خلص هذا البعض إلى القول إن المهرجان كان مليئا بالأفلام التي تم عرضها من قبل، وإذا ما قلت اعتبروا ذلك حسنة مضافة إلى حسناته. لكن على الرغم من أننا جميعا نحب أن نجد البرنامج مليئا بالمفاجآت، يجب أن لا ننسى أن المهرجان العربي، أيا كان، لا يعرض أفلامه للنقاد والصحافيين العرب وحدهم، بل لديه واجب توفير أفضل ما تم إنتاجه عالميا على الجمهور الكبير الذي – بطبيعة الحال – لم ينتقل إلى برلين أو كان أو فينيسيا أو تورونتو أو سواها لمشاهدة ما عرض في تلك المهرجانات، بل انتظر من مهرجانه المحلي عرض ما سمع به وقرأ عنه.
هذا ما يفعله مهرجان أبوظبي مواكبا مرحلة جديدة بدأت في العام الماضي، مع تسلم مديره الإماراتي علي الجابري مهامه كمدير عام المهرجان. المرحلة السابقة بدورها يمكن تقسيمها إلى قسمين؛ إدارة تأسيسية شملت الإعلامية نشوى الرويني والناقد سمير فريد، ثم أخرى من العام الثالث شملت إدارة أميركية لبيتر سكارلت الذي عمل بجهد ملحوظ، لكي يجعل من مهرجان أبوظبي لقاء عالميا.
المشكلة كانت في أن المهرجانات العربية بحجم أبوظبي أو الدوحة السابق أو دبي أو مراكش لا تستطيع أن تكون عالمية لدرجة التأثير على اختيار السينمائيين المطلق. ليس من السهل أن تجد منتجا أو مخرجا غير عربي سيفضل تفضيل مهرجان عربي على واحد من تلك الرئيسة الأربعة المذكورة أعلاه، فيخصصه له. والثانية كانت أن غياب السوق العربية الناضج كان وسيبقى عاملا يحد من مهام المهرجانات العربية احتلال ذلك الحجم الكبير على الخارطة الدولية بين المهرجانات.
الإدارة الجديدة استوعبت ذلك، والنتيجة أنها في الوقت الذي يبدو فيه، وقد تكون هذه القراءة غير دقيقة، سقف توقّعاتها، لم تحصر نفسها في نطاق ضيق. المهرجان صار أكثر انضباطا ولم يتوقّف، في الوقت ذاته، عن محاولته لمنح مشاهديه الهامش العريض من الأفلام عرضت أو لم تعرض في مهرجانات سابقة.
* نزاعات مستمرة
* واحد من المواضيع الأكثر طرحا التي تشكّلها الأفلام المشتركة هو موضوع الحروب الراهنة حول العالم وتبعاتها. وذلك عبر مجموعة من الأفلام العربية وغير العربية. ليست أفلاما حربية بالتحديد (ليس منها ما هو «رسائل من إيوا جيما» أو «إنقاذ المجند رايان») لكنها تتعامل وحروب العالم الفالتة من دون عقال، تلك التي ولت كما تلك التي لا تزال مستمرة. بالنسبة لتلك المستمرة، هي تأتي في سياقات متعددة لحروب بعضها داخلي وبعضها الآخر صغير، وبين تيارات أكثر مما هو بين آيديولوجيات، أما بالنسبة لتلك التي ولت، فإن الأفلام التي تتابعها تتحدّث عنها كمؤثر واضح إما على تلك النزاعات التي ما زالت مستمرة، أو لمجرد أن تلك التأثيرات ما زالت متسمرة، كما دوائر الماء الراكد حين رمي أحجار فيها.
«بلادي الحلوة.. بلادة الحادّة» لهينر سليم (المسابقة) يتناول وضعا اجتماعيا في القطاع الكردي من العراق. وانطلاقة حكايته التي وضعها المخرج لجانب أنتوني لاكومبلي، تبدأ بتهنئة جندي كردي على ما أبلاه في المواجهات التي وقعت بين القوات الكردية وتلك العراقية في الحروب السابقة، قبل أن يطلب منه التوجه إلى نقطة حدودية لكي يشرف على أمنها. إذ يقبل المهمة، ويصل ليجد أن مركز الشرطة لا يحتوي إلا على معاون واحد، وأن البلدة تستمد حياتها من طبيعة قاسية (على جمالها) تحيط بها، يواجه على الفور عصابة من المهربين وأخرى من المتسلطين الذين يريدون تطويع القانون لخدمتهم. مما يجعل هذا الفيلم تداولا لأحداث مرتبطة بالعراق قبل حرب 1994 هو أن يطرح مشكلة ناشئة عن فلتان أمني في مرحلة ما بعد صدّام، لا ليغدق على المرحلة المذكورة وصفا إيجابيا ما، بل ليكشف عن ضرورة القبول بالقانون كشرط لتطور الحياة الاجتماعية وللمجتمع حتى في ربوعه القاسية تلك.
الفيلم العراقي الآخر المشترك في المسابقة هو «تحت رمال بابل» لمحمد الدراجي، المخرج الذي سبق له أن تناول الحياة ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، في فيلميه الروائيين الطويلين السابقين «أحلام» و«ابن بابل». «تحت رمال بابل» يتولى تقديم حكاية مجند كردي في الجيش العراقي يشهد اندحار القوات العراقية من الكويت، بفعل الحملة العسكرية الأولى التي سميت بـ«حرب الخليج» ويقرر الانفصال عن وحدته. لكنه يقع في الأسر ويتهم بالعمل لتقويض النظام. إذ يسجّل المخرج تبعات هذه التهمة يتداول الوضع برمته من خلال حكاية مأسوية هي فردية وعامة في الوقت ذاته.
من مصر يتطرق «فرش وغطا» لأحمد عبد الله («مايكروفون» قبل ثلاث سنوات) لبعض ما شهدته الاضطرابات السياسية العاصفة التي وقعت في بلده. بطله سجين شاب «آسر ياسين»، يبحث عن ملجأ آمن بعدما وجد نفسه في جملة من تمّ تهريبهم خلال حملة الجماعات المناوئة لثورة الربيع في عام 2010. بات عليه الآن أن يكتشف مصر جديدة تعيش وضعا اجتماعيا مضطربا وقاسيا.
* نماذج سابقة
* خارج المسابقة الروائية تطالعنا أفلام راصدة أخرى لعل «همس المدن» للعراقي قاسم عبد أكثرها، ونحن لم نرَ الفيلم بعد، إثارة للفضول. فهو صوّره في ثلاث مدن ليعرض حالاتها الاجتماعية الحاضرة وليلحظ مآلاتها التي تدعو للتأمل. مما يجعله على قدر من التميّز، ظاهريا على الأقل، حقيقة أنه فيلم يجمع بين الروائي والتسجيلي على نحو صامت. الأصوات التي نسمعها هي أصوات الحياة، لكنه لا يحوي حوارات بين البشر لأن الغاية، كما يقول المخرج «هي العودة إلى مهمّة التعبير بالصورة، لأن السينما لها لغة منفردة علينا أن نؤكد عليها».
تسجيليا أيضا، قام المخرج دان كراوس بتوفير كثير من الوثائقيات والمقابلات في فيلمه الجديد «فريق القتل»، الذي استلهم موضوعه من اعترافات جندي أميركي عايَش الحرب الأفغانية ويسجل هنا لا معارضته وحدها، بل الأسباب التي تدعوه للمعارضة. يحكي عن الانتهاكات الإنسانية التي أثرت فيه ودفعته للكتابة إلى والده طالبا منه التدخل لإخراجه من الجحيم الذي وجد نفسه فيه. ليس هو بالضرورة معاديا للمبادئ التي دفعت الولايات المتحدة للحرب، لكنه لم يعد – وقد شهد تصرفات سواه من رفاق السلاح – يجد أن الحرب يمكن لها أن تنجز أي هدف سوى إشاعة الفوضى وانتهاك حقوق الإنسان.
ومن أفغانستان إلى بوسنيا تأخذنا المخرجة ياسميلا جبانيتش في فيلمها الجديد «لمن لا يستطيعون سرد الحكايات»، إلى بلدة تقع بالقرب من الحدود الصربية تصل إليها بطلة الفيلم سائحة وتغادرها صاحبة قضية تتعلق بما وقع في تلك البلدة من مجازر وانتهاكات وحالات اغتصاب بات الجميع يفضل السكوت عنها. جبانيتش ليست غريبة عن معالجة هذا الجرح النازف دائما في بطن الذاكرة (بل فيها أيضا كامرأة بوسنية)، فقد سبق لها أن قدمته في أكثر من فيلم كل منها انطلق من زاوية مختلفة. لكن هذا الفيلم ربما أكثر أعمالها انصرافا لمعالجة وضع بوسنيا خلال وبعد الحرب الأهلية هناك.
ليس أن كل ما هو معروض هنا أفلام هموم ومشكلات اجتماعية، بل إن عددا آخر يتداول مناطق إنسانية واجتماعية مختلفة وأقل علاقة بالجانب السياسي وتبعات الحروب. لكن الفترة التي يعيشها هذا الجزء من العالم لا بد أن تفرض على بعض صانعي الأفلام الرغبة في تناول المشكلات الاجتماعية والأمنية الحاصلة. وهو اهتمام بدأ حتى قبل ما يسمّى بالربيع العربي.
أحد الأفلام المعروضة في قسم خاص بأفلام المخرجين الأولى هو الفيلم اللبناني «بيروت الغربية» لزياد الدويري، الذي أنجزه سنة 1998، أي بعد نحو أربع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، وقبل 15 سنة، مما نشاهده اليوم من احتمالات حرب جديدة. ليس أن فيلم الدويري تنبأ بها، لكنه انضم، أراد أو لم يرد، إلى ذلك الهامش العريض من الأفلام العربية التي إن لم تتحدث عن القضية الفلسطينية، وجدت أمامها قضايا كثيرة أخرى مشابهة، ما زالت غير محلولة.
وعلى الصعيد المصري، فإن «578» لمحمد دياب حول موضوع التحرّش الجنسي المنتشر في القاهرة، من خلال تجارب ثلاث نساء، و«الخروج» لهشام عيساوي المتحدّث عن حب مسلم لقبطية (والممنوع من العرض اليوم) كما «الشتا اللي فات» لإبراهيم البطوط عن معتقل سياسي سابق ينطوي على نفسه حين شهد أحداث يناير (كانون الثاني) 2010، خوفا من أن يُلقى القبض عليه من جديد، ما هي إلا أعمال عاشت المخاض أو تلته لتتحدث فيه وتعلق عليه بما يتناسب وضرورة المرحلة بأسرها.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط