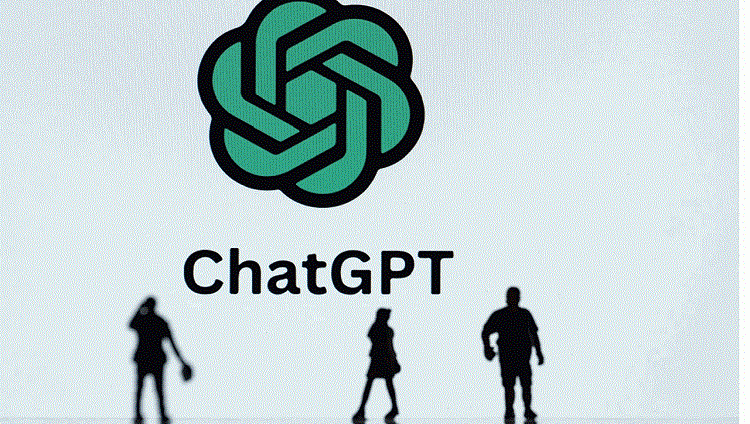إبراهيم العريس وجه حاضر في معظم التظاهرات السينمائية عربياً وعالمياً، فهو باحث في التاريخ الثقافي وصحافي وناقد سينمائي ومترجم ولد في بيروت 1946، درس الإخراج السينمائي في روما والسيناريو والنقد في لندن. يعمل بالصحافة منذ عام 1970، ويرأس حالياً القسم السينمائي في صحيفة «الحياة»، كما يكتب فيها زاوية يومية عن التراث الإنساني وتاريخ الثقافة العالمية بعنوان «ألف وجه لألف عام».
ترجم نحو أربعين كتاباً عن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية في السينما والفلسفة والاقتصاد والنقد والتاريخ، من أهم مؤلفاته: رحلة في السينما العربية، مارتن سكورسيزي ـ سيرة سينمائية، الصورة الملتبسة عن السينما في لبنان، الحلم المعلق عن سينما مارون عبود، السينما والمجتمع في الوطن العربي ـ القاموس النقدي للأفلام، وغيرها.
هو ابن المخرج والمنتج السينمائي اللبناني علي العريس والممثلة آمال العريس، كانت بداية علاقته العملية بالسينما أولاً من عائلته، ثم عندما تعرف إلى السينمائيين المصريين الذين غادروا إلى لبنان بعد تأميم السينما المصرية في الستينات، عمل في عدة مهن سينمائية وشارك في إعداد بعض الأفلام العربية المصورة في تركيا وإيران وعمل كمساعد مخرج في أكثر من 30 فيلماً منها: عصابة النساء، إيدك عن مراتي، حسناء البادية.
أخيراً، كرمته جائزة الصحافة العربية في دورتها الخامسة عشرة، حيث تم منحه جائزة العمود الصحافي خلال حفل كبير في دبي.
«البيان» التقت إبراهيم العريس في حوار طاف على عدة محطات من مسيرته المهنية منذ سبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى يومنا الحاضر
ترافق الحياة الثقافية العربية منذ السبعينيات كصحافي وناقد، وقد ترأستَ القسم الثقافي في جريدة «السفير» اللبنانية ثم مجلة «اليوم السابع» في باريس، وأسست مجلات ثقافية مثل «المسيرة» و«المقاصد»، والآن أنت تشرف على الملحق السينمائي في «الحياة»، إضافة إلى مقال يومي في شؤون الثقافة والفن والحضارة. كيف تستعيد هذه المسيرة الطويلة التي اجتزتها؟ أي المحطات هي التي تعدها الأبرز خلالها؟ ثم ماذا عنى لك الانتقال من الصحافة المحلية أو المقيمة إلى الصحافة المهاجرة؟
الحقيقة أن سؤالك الأول هذا يحيّرني، لأني أبداً لم أطرحه على نفسي من قبل. فأنا من النوع الذي يرى أن ما صنع ما هو عليه الآن، إنما كان كل تلك المراحل التي مرّ بها. فلكل مرحلة من حياتي ولكل مهمة قمت بها، مكانتها ونكهتها وحياتها التي عشتها. ولكن بصراحة، ربما تكون مرحلة «اليوم السابع» في باريس، الأكثر بروزاً، وربما إثارة للحنين أيضاً. أولاً، لأن المجلة نفسها اعتبرت من أفضل إنجازات الصحافة العربية، وكانت نوعاً من ارتباط خاص بالقضية الفلسطينية، بعدما كانت هذه القضية ضُربت وضربت نفسها في لبنان.
والأهم من هذا أنها كانت سنوات تعايشت فيها مع بعض أقرب أصدقائي من الذين رحلوا تباعاً، من جوزيف سماحة إلى محمود درويش وإميل حبيبي والباهي محمد وصالح بشير وسمير قصير وجورج طرابيشي ومحمد عابد الجابري… كلهم كانوا هناك وكلهم خسرناهم. وللمناسبة أود هنا أن أوجه التحية والدعاء بالشفاء إلى الصحافي القدير بلال الحسن الذي جعل تلك التجربة والمغامرة ممكنة!
مؤرخ الثقافة
هل تصنف نفسك ناقداً سينمائياً في المرتبة الأولى أم تفضل أن تُسمى ناقداً ثقافياً، نظراً إلى اتساع دائرة اهتماماتك الصحافية والنقدية؟
أحب عادة أن أنظر إلى نفسي كمؤرخ للثقافة، حيث إن عملي «الأساسي» كناقد سينمائي، يندرج في إطار هذا النشاط الذي أرى فيه هوايتي الأولى ومبرر وجودي، بل نوعاً من الكتابة اليومية لسيرتي الذاتية. وأنا اليوم إن استرجعت مساري المهني، لن أرى إلا أنني اشتغلت أكثر ما اشتغلت على تاريخ الثقافة وارتباطه الأساسي بتاريخ الذهنيات.
هوايتي المحببة
عملتَ أيضاً في قضايا الفكر العربي وحاورتَ أعلام هذا الفكر مغرباً ومشرقاً وأصدرتَ كتباً في هذا الحقل. ما الذي دفعك كناقد سينمائي إلى الخوض في مجال الفكر العربي؟
حسناً، سأحاول هنا جواباً ربما لن يكون مفهوماً تماماً: إذا كانت السينما ونقدها عملاً أمارسه بشكل متواصل ضمن إطار اهتمامي بالتاريخ الثقافي، فإن الفكر – والفرع الفلسفي منه على وجه الخصوص – هو بالنسبة إليّ هوايتي المحببة ومن هنا أصارحك بأنني أقرأ من الكتب الفكرية والفلسفية أضعاف ما أقرأ في السينما والفنون عموماً.. ومن هنا يبزغ لديّ بين الحين والآخر ذلك التوق لإجراء حوارات فكرية – فلسفية، أو إلى ترجمة كتب فكرية وحتى اقتصادية أو التأريخ لفيلسوف من الفلاسفة وما إلى ذلك. ولنضف إلى هذا اهتمامي الأساسي، فكرياً، بعصري النهضة العربيين (نهضة أواخر القرن التاسع عشر، ونهضة ما بعد هزيمة حزيران 1967).
ثم إنني أعتقد على أي حال أن على الناقد السينمائي – الحقيقي – أصلاً أن يكون ملماً ومتعمقاً بكل ما ينتمي إلى الفكر والأدب والفن. فبما أن السينما تشتمل على كل شيء من الرواية إلى الموسيقى والنظرة إلى الوجود والتحليل النفسي والفن التشكيلي.. لا يمكنني أن أفهم ألاّ يلم الناقد بكل هذه الأنواع حين يكتب عن فيلم أو تيار سينمائي..
مثقف شمولي
قد يأخذ عليك البعض شمولية التجربة التي تخوضها وقد يؤيد البعض لديك هذا التعدد، أنت كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل مازال الكلام ممكناً اليوم عن مثقف شمولي؟
أنا لا يمكنني أن أفهم كيف يمكن أن يكون المثقف غير شمولي. فالثقافة والوعي المرتبط بها، لا يتجزآن، الجواب يكمن في أجوبة السؤالين.
تصنيفات ام احكام
كيف تنظر إلى الأثر الذي تركته الثقافة المابعد حداثية، ثقافة العولمة والثورات المعلوماتية في العمل الصحافي بصفتك ناقداً مخضرماً عاش التجربتين؟ هل تعتقد أن الإنترنت خدم الصحافة أم أثر فيها سلباً، بعدما قنّن مراجعها ومصادرها؟
لست أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النوع من التصنيفات: حداثية، مابعد حداثية، أو مابعد بعد حداثية. استخدامها ولا سيما دون فهم تاريخياتها وأبعادها الحقيقية يدخل الناس في متاهات مضحكة. هل يمكن لأحد ما أن يعتقد مثلاً، أن محمد شاكر أكثر حداثة من القديس أوغسطين، أو أن إحسان عبدالقدوس أكثر حداثة من ستندال، أو حتى أن الفنانة نانسي عجرم أحدث من منيرة المهدية أو من فيروز أو ماجدة الرومي؟ إنها مجرد تصنيفات أكاديمية تحولت بقدرة قادر إلى أحكام قيمة!
أما بالنسبة إلى الإنترنت فهو وعاء ديمقراطي يمكن أي إنسان من أن يكتب.. ولكن ليس من أن يكون كاتباً! كما أن الكاميرات الحديثة تمكن أياً كان من أن يصوّر لكنه لن يكون مخرجاً أو مبدعاً سينمائياً.
ثورة المعلومات فائقة الأهمية وتنتمي إلى الديمقراطيات الفكرية الجديدة المرتبطة بالعولمة، لكن لا علاقة لها بالإبداع الذي ستظل له إلى الأبد استقلاليته ومكانته وإن تغيرت وسائط وصوله إلى الناس.
أما بالنسبة إلى الصحافة نعم هناك خوف عليها كحامل ورقي، تماماً كما خفنا على السينما كشريط من السيليلويد. لكن السينما باقية – ويا حسرتاه على الصالات، وكونها أماكن تجمّع لمتفرجين يمارسون معاً لعبة تلقّ رائعة ربما لن يكون لها مستقبل! – والصحافة باقية وإن بوسائل أخرى – ويا حسرتاه على الحبر والورق! ويا لسعادة الغابات والأشجار! – تبقى مسائل لا بد من أن تزداد دراستها حول مواثيق الشرف الكتابية ومصداقية المواقع الإلكترونية، وفي عرفي أنها مسائل ترتبط بالقيم لا بقضية الإبداع نفسها.
الفرد الموسوعي
في عملك الموسوعي الأدبي والفني والحضاري تشتغل بصفتك فرداً وقد أصدرت مقالاتك هذه في موسوعة تضم أجزاء عدة. هل تعتقد أن الفرد ما زال يقدر أن يقوم وحيداً بالعمل الموسوعي اليوم بعد تشتت المعارف واتساع دائرتها؟
أنا مؤمن بالفرد ولن أتوقف عن الإيمان به حتى آخر لحظات عمري. الأفراد هم الذين يصنعون التاريخ والإبداع.
وضعت كتاباً ضخماً عن السينما اللبنانية وكتاباً موسوعياً عن السينما العربية، إضافة إلى كتب عدة في النقد السينمائي. هل تعتقد أن حنينك الأول والأخير هو إلى السينما؟
ربما هو بعد كل شيء الموضوع الذي يستهويني أكثر من غيره.. وربما لسهولة خوضي فيه.
مهرجانات تختفي
مهرجانات السينما العربية كثيرة، تقابلها سينما عربية قليلة الإنتاج، وفي بعض الدول معدومة، برأيك كيف تستقيم المعادلة؟
ولكن المهرجانات تختفي أحياناً من دون إنذار! نحن على كل الصعد في مرحلة انتقالية. وربما يكفي نجاح فيلم واحد أحياناً لانفجار إنتاجي لم يكن أحد يتوقعه! ومع هذا لست أرى علاقة حقيقية يمكن بناء تحليل مقنع عليها، بين المهرجانات وإنتاج الأفلام.
تشهد الصحافة الثقافية عموماً حالاً من التراجع، لا سيما بعدما صارت تفتقر إلى النقد المتخصص وأصبحت محصورة في أداء وظيفتها الخبرية. كيف ترى مستقبل هذه الصحافة الثقافية في العالم العربي؟
هو أمر مؤسف بالتأكيد… فالثقافة لا تغيب فقط عن الصحافة بل تغيب أيضاً عن شاشات التلفزة، حيث ثمة هجمة لكل ما هو سطحي… هي معركة يجب خوضها على أي حال. وكما قلت لك نحن نعيش مرحلة انتقالية لا يمكن أن نتصوّر منذ الآن كيف ستكون خاتمتها، أو على الأقل مرحلتها المقبلة.
نزاهة وتعزية
فزت أخيراً بجائزة «العمود الصحافي» ضمن جوائز الصحافة العربية التي تمنحها دبي، كيف تنظر للجوائز الصحافية، وهل تناسب حجم الصحافة العربية وتطوراتها؟
هو فوز أسعدني خصوصاً أنه أتى من مجموعة من الناس أحترمها، مؤكداً لي نزاهة ليست معهودة في عالمنا العربي.. ولعل جائزتي وجوائز الزملاء الآخرين الذين فازوا معي، هي الوحيدة التي تنمح للصحافة في وطننا العربي معزّية إياها عن الانهيار الذي تعيشه، ولاسيما في أماكنها العريقة. أما مسألة الأحجام والتناسب فهي مسألة نسبية، لا يمكن الحكم فيها طالما أن ليس لدينا إمكانية للمقارنة!
كتاب الأعمدة في الصحافة العربية باتوا معدودين، هل تعتقد أن الصحافة الورقية تعلن أفولها مع أفول كتاب الرأي وتقلص دورهم؟
نعم.. الجيل الأخير بين عدد كبير من العاملين في الصحافة الورقية تنتشر فكرة (نحن الجيل الأخير الذي يعمل في الصحافة الورقة) هل تعتقد بانتصار العالم الافتراضي على الواقعي إعلامياً.
لماذا علينا أن نصف عالم الصحافة غير الورقية بأنه عالم افتراضي؟ أنا لست موافقاً على هذا المصطلح، بل أقول إنه إن اختفت الصحافة الورقية لن يعني هذا اختفاء الصحافة ككتابة تلاحق ما يحدث وتخبر به وتعبر عن رأي في شأنه وتحلل غوامضه. بل سيعني أننا رحمنا الأشجار والبيئة، ويبقى علينا أن نعثر على وسائط أخرى للتعبير عن أنفسنا وإخبار الناس بما نريد أن نخبرهم به.
قبعة مرفوعة
يوجد تعبير جميل في الغرب دخل إلى لغتنا وعالمنا العربي وهو – (أرفع قبعتي لك تحية واحتراما وإعجابا )، وهذا هو بالذات التعبير الذي أريد أن أستخدمه وأسجله في بداية حديثي عن الصحفي اللبناني الكبير الأستاذ إبراهيم العريس، الذي أتابع – بإعجاب – منذ زمن ليس بالقصير مقالاته الثقافية المعمقة في الأدب العربي والعالمي التي ينشرها في الصحافة العربية. هناك اختلافات وفروق بين البحث العلمي والمقالة، ولكن كتابات إبراهيم العريس تمزج بينهما إبداعيا بشكل يكاد يقترب من صيغة جديدة لدرجة أننا نستطيع – بسهولة – تطوير معظم مقالاته وتحويلها إلى بحوث علمية رصينة لأنها مكتوبة وفق خطة دقيقة ومحددة وواضحة المعالم. ولعل أبرز ما في هذه المقالات هي الروح المهنية الموضوعية التي تسود فيها، والنظرة العلمية الشاملة والمتكاملة والعميقة إلى الموضوع، إضافة إلى أن تلك المقالات لا تخضع للمواقف السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. ضياء نافع/ موقع كتابات الإلكتروني
من الورق
يهدي إبراهيم العريس كتابه الضخم «السينما والمجتمع في الوطن العربي- القاموس النقدي للأفلام» (496 صفحة) إلى ذكرى «يوسف شاهين وتوفيق صالح ومارون بغدادي وصلاح أبو سيف وعمر أميرالاي ورأفت الميهي ومحمد الركّاب وكثيرين غيرهم من الذين لم يختاروا أسهل الدروب، فأعطوا السينما العربية أعمالاً جعلتها بحق فناً عظيماً بين الفنون الجميلة».
وفي مقدمته الطويلة، يكتب إبراهيم العريس عن الأزمة السينمائية الراهنة في ظلّ المناخ الانتقالي الحادّ الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية، على كلّ الصعد. ويركّز على اختياراته للأفلام العربية التي تشكل مادة الكتاب، وهي تختلف في توجهاتها وحقباتها وقضاياها.
ومن تلك الأفلام: «عودة الابن الضال»، «سفر برلك»، «الأبواب المغلقة»، «أحلام هند وكاميليا»، «الأراجوز»، «الأرض»، «أريد حلاً»، «أفواه وأرانب»، «أم العروسة»، «باب الشمس»، «بيّاع الخواتم»، «حروب صغيرة»، «زوجة رجل مهم»، «سواق الأوتوبيس»، «عفاريت الإسفلت»، «عرق البلح»، «عمارة يعقوبيان»، «فجر يوم جديد»، «فلافل»، «لما حكت مريم»، «مارا»، «هي فوضى؟»، و«وهلأ لوين؟».
(عن كتاب السينما والمجتمع في الوطن العربي)
من مؤلفاته
«الصورة والواقع» (1978)
«رحلة في السينما العربية» (1979)
«الكتابة في زمن المتغيّر» (1979)
«علامات الزمن» (1986)
«لغة الذات والحداثة الدائمة» (1994)
«التاريخ والعالم» (2008)
«الشاشة والمرأة» (2009)
«نظرة الطفل وقبضة المتمرد عن سينما يوسف
شاهين» (2009)
«ما وراء الشاشة» (2010)
«من الرواية إلى الشاشة» (2010)
المصدر: البيان