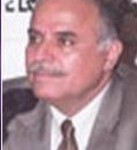تلتقيه فتشعر بجاذبية نحوه.. تحاول أن تبقيه معك كي تستفيد من مخزونه الثقافي وتجاربه الغزيرة فيهرب منك دون أن تشعر.. يغيب عنك مددًا طويلة ثم تراه أمامك فجأة.. تسعى لمعرفة ما يدور في ذهنه من أحلام فلا يمنحك فرصة.
رجل صريح كحد السيف، لذا وصفوه بالشاعر المتمرد على الصمت المنافق. إنسان ساحر في حديثه ونتاجه الفكري كسحر بلاده الطيبة. شاعر استثنائي من بلد فضل أن يكون استثنائيًا ضمن منظومته الإقليمية. شخصية عاشقة للترحال والاختلاط بالثقافات والشعوب لذا وصفوه بالشاعر الذي لا يستكين ولا يستقر.
ذلك هو الشاعر والكاتب العماني المعروف «سيف بن ناصر بن عيسى الرحبي» الذي انطلق من مسقط رأسه في قرية «سرور» بولاية سمائل الداخلية، حيث أبصر النور سنة 1956، ليجوب العالم دارسًا تارة، وباحثًا عن عمل تارة أخرى، وموظفًا تارة ثالثة، وسائحًا تارة رابعة، وباحثًا عن الحب والجمال والفن تارة خامسة، وبوهيميا يعيش على هامش الحياة تارة سادسة.
التقيته للمرة الأولى في بيروت السبعينات. كان اللقاء في مقهى «الويمبي» بشارع الحمرا الأثير، الذي اعتدت وزملاء الدراسة العمانيين أن نتناول فيه القهوة يوميًا. وكان الزمن وقتها هو زمن الانكسارات الذي يحاول التقاط أنفاسه من خلال التمنطق بشعارات اليسار القومي والماركسي وخطاب الكفاح المسلح وعبادة طواطم ورموز بعينها.
وقتها كان الرحبي مثلنا ومثل الكثيرين من جيل السبعينات لجهة التماهي مع الخطاب الثوري العنيف كطريق للتغيير. غير أن هذا لم يستمر طويلاً، لا في حالتنا ولا في حالة الصديق سيف الرحبي الذي اكتشف سريعاً أن التغيير ممكن أيضا بوسائل أخرى غير العنف، خصوصًا مع عملية الإصلاح التي قادها جلالة السلطان قابوس سنة 1970 وأعطت ثمارها وبشائرها في زمن قصير.
وهكذا خلع الرحبي ملابس الثوار ومنظري الكفاح المسلح وأرتدى مثلنا ملابس التمتع بمباهج الحياة والتأمل في الطبيعة والكتابة الإبداعية والاهتمام بالسينما والموسيقى. غير أنه كان في عجلة من أمره.. كان يريد أن يرى الدنيا كلها ويسوح فيها ويكتب عنها ويختلط مع شعوبها، وبالتزامن كان يحلم بإكمال دراسته كغيره من مواطنيه الذين اضطرتهم ظروف بلادهم الصعبة للهجرة من أجل مستقبل علمي وعملي أفضل.
غاب عنا الرحبي سريعًا واختفت أخباره، وحينما سألت أحدهم عنه قال: «لا عليك.. هو هكذا يظهر فجأة ثم يختفي فجأة، لكنه حتمًا سيعود». وقد عاد الرجل فعلاً ثم غاب مجددًا، فتيقنا أنه لا يستقر في مكان. وقتها كانت تنقلاته لا تتعدى عواصم العرب الكبرى.. القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد قبل أن يرحل بعيدًا نحو شمال أفريقيا، ومن ثم نحو أوروبا التي أسرتْ شغاف قلبه بجمالها ونظامها وحضارتها وعباقرتها في مختلف الفنون والعلوم.
وكلما عدتُ إلى حكاياتي مع سيف الرحبي، لابد لي من استعادة شريط ذكرياتنا في القاهرة التي احتضنتني بعد خروجي القسري من بيروت بسبب حربها الأهلية القذرة، حيث كانت لنا صولات وجولات في فنادقها الأربعة الكبرى آنذاك (شيراتون الجيزة وهيلتون النيل والمريديان والميناهاوس)، وجلسات شاعرية، ونقاشات في السياسة والأدب والترحال، ومشاغبات ومفارقات ظريفة، وجولات لاستكشاف الحياة في «أم الدنيا» وقراءة أفكار ناسها بعد مجيء السادات وإطلاق سياسات الانفتاح الاقتصادي.
كما قلنا ولد الرحبي في «سرور» وهي قرية نائية في عمان الداخل، على بعد 70 كيلومترا من مسقط، وتحيط بها جبال جرداء أسطورية الشكل، لكنها في الوقت نفسه خضراء بسبب وديانها وجداولها. تلك القرية شكلت عالم الرحبي الوحيد خلال سنوات ترعرعه ونشأته الأولى ودراسته في الكتاتيب التقليدية، بل كان لبيئتها البرية العجيبة الصادحة بأصوات الذئاب وبنات آوى والحيوانات الأخرى تأثير واضح وجلي على نتاجه الأدبي في فترة لاحقة. وقتها ورغم صغر سنه كان يبدو متلهفًا للقراءة والاطلاع خارج أسوار الكتب التقليدية الصفراء. لكن المكتبات كانت معدومة ومكتبة والده لم تكن تضم سوى كتب التراث والفقة واللغة والتاريخ القديم التي لم يكن يستهويها.
عن مرابع طفولته قال الرحبي: «قريتي في عُمان، ليست بعيدة عن مشارف الربع الخالي، هذه الصحراء المروّعة، التي وصفها رحالة إنجليزي في مطلع القرن العشرين (صحراء الصحارى)، أو (أمّ الصحارى)، لكن بالنسبة لي مكانيًا، ورمزيًا، تتحول في الكتابة والنص إلى صحراء كونية، ورمزٍ وجودي للوحشة والعدم، فالصحراء هنا ببعدها الواقعي والرمزي ظلّت ملحة في النص، أكثر من العناصر الجغرافية، والجيولوجية الأخرى التي تزخر بها عمان كالجبال، والبحار».
بعد تخرجه من كتــّاب القرية، انتقل إلى عالم أوسع نسبيًا هو عالم العاصمة مسقط التي أنهى بها دراسته الابتدائية في المدرسة السعيدية، ومعه عالم مدينة مطرح المجاورة حيث البحر والنوارس والحوانيت العتيقة وقصص الغزاة البرتغاليين وتجار الهند والسند وصناع المراكب المتجهة صوب زنجبار وممباسا. وكغيره من العمانيين العاشقين للتحصيل العلمي هاجر الرحبي من بلاده طلبًا للعلم وهو صبي قليل التجربة لا يتجاوز سنه الرابعة عشرة، فألقى رحاله في القاهرة، التي كانت وقتذاك مثل نيويورك مقارنة بمسقط.
في القاهرة أنهى الرحبي مرحلتي الدراسة الإعدادية والثانوية، وأتبعهما بالالتحاق بقسم الصحافة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. غير أن القاهرة بالنسبة إليه لم تكن مجرد مكان للتحصيل العلمي فقط، وإنما أيضا مكان تحرر فيه من سطوة والده الذي كان معارضًا ومعاديًا لجميع وسائل العصر التكنولوجية بما فيها المذياع. ولا نبالغ لو قلنا أن القاهرة كانت مكان ميلاده الثاني بعد قرية «سرور»، ففيها تلقى الصدمات الحضارية واكتشف الكثير من مدهشات العصر وأسس لنفسه أفقًا مختلفًا بعيدًا عن أفقه العماني الضيق واكتسى بنزعة معرفية ووجدانية وسياسية جديدة.
يمكن تقسيم حياة الرحبي إلى ثماني مراحل بحسب الأماكن التي عاش فيها:
في مرحلته العمانية عانى كثيرًا من سطوة والده ومن شظف العيش وبؤس الحال وغموض العالم المحيط. وفي مرحلته القاهرية اكتشف نفسه وبدأ يحتك بالآخر وينشغل بالأوضاع السياسية والفكرية ويقرأ لرواد الشعر الحديث من أمثال السياب وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل، ويكوّن الصداقات مع رموز الفكر والأدب، ناهيك عن تجرعه للوعات الحب الأول.
أما مرحلته السورية واللبنانية فقد تميزت بانحسار همومه السياسية لصالح الهاجس الأدبي والشعري قراءة وكتابة وانتاجًا، بدليل أنه أصدر من دمشق عام 1980 ديوانه الشعري الأول بعنوان «نورسة الجنون»، وأتبعه في عام 1981 بكتاب شعري / قصصي تحت عنوان «الجبل الأخضر»، قبل أن تتوالى إصداراته. كما اشتملت المرحلة التي عاشها ما بين دمشق وبيروت على العمل كمراسل لأكثر من صحيفة خليجية، وذلك من باب مواجهة التزاماته المعيشية.
بعد ذلك جاءت مرحلته الجزائرية التي بدأت بانتقاله إلى هناك في حقبة مفصلية هي الحقبة التي تلت غياب الرئيس هواري بومدين بكل ما كان يمثله من كاريزما وشرعية ثورية وتنموية وتوجهات وطنية. وقد نقل عن الرحبي قوله إن رحيل بومدين ومجيء الرئيس الشاذلي بن جديد وما ظهر على هامش عهده من ظواهر التسيب والفساد كان وراء مرحلة الضعف والهشاشة في الحياة السياسية الجزائرية التي مهدت بدورها لبروز القوى والجماعات الاسلامية العنيفة ومن ثمّ حدوث الكوارث.
تلت مرحلته الجزائرية المرحلة البلغارية التي دامت أكثر من عام خلال الحكم الشيوعي لهذا البلد البلقاني الجميل. هذه المرحلة من حياته قضاه صاحبنا في بيت للطلبة بمنطقة جبلية معروفة بتساقط الثلوج عليها، حيث ابتعد عن الهاجس السياسي كليًا واستثمر جل وقته في تأمل الطبيعة الخلابة والاحتكاك بالناس والكتابة عن مشاهداته وأحاسيسه.
بعد بلغاريا سافر الرحبي في ثمانينات القرن العشرين إلى باريس مبتدئًا مرحلته الفرنسية، وكان سبب انتقاله إلى هناك هو الالتحاق بصديقين له من دولة الإمارات هما حبيب الصايغ ومحمد عبيد غباش اللذين أصدرا من العاصمة الفرنسية مجلتي «أوراق» و«الأزمنة العربية» على التوالي. غير أن الرحبي قبل الذهاب إلى باريس مرّ على لندن وكاد أن يستقر بها لولا حدوث إشكالات بينه وبين صحيفة الحياة اللندنية التي تلقفته. وفي باريس التي عاش بها الرحبي طويلاً وعمل فيها مراسلاً للعديد من المجلات والصحف العربية، كان ميلاده الثالث من بعد «سرور» والقاهرة. إذ عشق المدينة ومباهجها ومناخها الثقافي والفني بجنون، وكان لديه متسع من الوقت لاكتشاف المدن والنساء والأطباق وعقد الصداقات والتردد على المتاحف والجلوس على مقاهي الشانزليزيه والحي اللاتيني والسان جيرمان والسان ميشيل وغير ذلك مما أضاف إلى حياته السابقة حياة ملونة جديدة. ولهذا نجد لباريس في ذاكرة الرحبي موقعًا أثيرًا يعود إليه مهما بعد عنها. دعونا نقرأ ما كتبه في كتابه «سنجاب الشرق الأقصى» عن باريس بعد سنوات طويلة من ارتحاله عنها:
«باريس هي باريس التي لا تتغير، بل تزداد جمالاً كلما أوغلت في السنين، وتقدمت صوب دوائر الدهر، تبقى الأثيرة من بين كل المدن للشعراء والكتاب والفنانين. مدينة الرومانسية هذه يصل إليها الكاتب ليلاً، يفطر كما يفطر الفرنسيون كرواسون وقهوة، ثم لا بد من مرأى نهر السين فهو يطالعك أينما ذهبت، على ضفته يجلس الكاتب وحيداً، ليتابع حركة الزمن عبر نهر هراقليطس، يتابع حركة دوريّ شفاف يحوم حول الضفة، إنه الدوري الذي يراه المرء في كل مكان خفيفاً، باهراً وزاهداً في الطعام، وإذا كان لا بد من نهر السين فالكاتب لديه أصدقاء وذكريات غابرة في أزقة ومقاهي السان ميشيل والسان جرمان دو باريه والأوديون، المقاهي التي يحلو له الجلوس فيها مع من تبقّى من الصحاب القدامى، مسترجعاً معهم سيراً عابرة وذكريات مرّت، وصداقات كانت هنا وذهبت وطواها الزمن كعادته مع الكائنات الحية، لكن الشاعر لن يدعها منسية، فسرعان ما يعود إليها، لينبشها ويستحضرها، مستنطقاً نواحي الذكرى ومستجوباً بأسئلته أغوار الماضي. يذهب إلى حدائق لوكسمبورغ، يتجوّل بين بشر مرحين وكئيبين، مثل أي حياة أخرى، يستمتع بأمطار خفيفة، تنزل عليه كالنعمة هو القادم من الصحارى والربع الخالي والجبال الساخنة والجحيمية. متحف الفنون لا يبعد عنه سوى خطوات يذهب إليه، في ذهابه يتوقف أمام (البوزار) الأكاديمية الفنية التي تخرّج منها أشهر رسامي العالم. يمرّ بنهر بالسين حتماً فيرى بواخر النهر السياحية مليئة بأطفال وهم يضحكون ويصخبون، يلوّحون للعابرين والمتفرّجين».
لكن الرحبي، كما قلنا، لا يستكين وهو أشبه بالبدوي المتنقل أو أشبه بالطيور المهاجرة دومًا في جميع الاتجاهات. وهكذا نجده يترك فرنسا قاصدًا هولندا بعدما عثر في الأخيرة على فرصة عمل في القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية، معطوفة على وظيفة غير رسمية بسفارة بلاده في أمستردام التي فتحت أبوابها عام 1990.
وبإغلاق القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية عام 1994 لأسباب مالية، ترك الرحبي مدينة أخرى أحبها واكتشف خرائط وجهها، ليولي وجهه صوب الجزيرة العربية التي انطلق منها شابًا غرا. حيث ألقى رحاله لبعض الوقت في دولة الإمارات وسط أصدقاء وأحبة طال غيابه عنهم، قبل أن يعود إلى بلاده عمان.
وهكذا عاد صاحبنا إلى عشه الأصلي في منتصف التسعينات تقريبًا، لكن بعد أن جال وتعلم وتثقف واكتشف ومزج ثقافته الشرقية بالثقافة الغربية وبنى لنفسه في ساحة الأدب والشعر والصحافة اسمًا في خط بياني صاعد ولافت من خلال إصدار العديد من الدواوين الشعرية والأعمال الإبداعية ومنها حتى ذلك التاريخ: نورسة الجنون، الجبل الأخضر، أجراس القطيعة، رأس المسافر، مُدية واحدة لا تكفي لذبح عصفور، منازل الخطوة الأولى، ذاكرة الشتات، رجل من الربع الخالي.
ومن محاسن الصدف أن عودته إلى بلده تزامنت مع توجه رسمي لإصدار مجلة ثقافية فصلية جادة تعكس طموحات سلطنة عمان وأبنائها في نشر الإبداع والتنوير والحداثة وفق أساليب غير مألوفة أو مستهلكة. ومن رحم هذه الرغبة ولدتْ مجلة نزوى في عام 1994، واختير الرحبي كأول رئيس تحرير لها تكريما لمسيرته الإبداعية. فكان الاختيار والتكريم في مكانهما الصحيح، حيث شهدت «نزوى» نجاحًا معتبرًا بفضل الأقلام المتميزة التي استقطبها الرحبي من كل مكان، ناهيك عن الأقلام المحلية التي حرص على دعمها وإبرازها، على الرغم من أن المشروع كان خياليا وجاء في زمن كانت فيه كل المجلات الأدبية في العالم العربي قد أشرفت على الموت والانطفاء. ولم تمضِ سوى سنوات معدودة وإلا عمان تكرمه مجددًا بصدور مرسوم سلطاني في فبراير 2010 قضى بتعيينه مستشارًا فى مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان بالدرجة الخاصة. وما بين هذا وذلك مــُنح الرحبي أيضا بموجب مرسوم سلطاني عضوية مجلس الدولة للفترة من 2007 إلى 2011، علمًا بأن هذه العضوية لا ينالها سوى من أدى خدمات جليلة لبلاده. وفي عام 2013 حصد جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب عن مجال الشعر العربي الفصيح التي أهداها إلى ولديه ناصر وعزان وأمهما الفنانة التشكيلية بدور الريامي.
وبعد عودته إلى وطنه، وعلى الرغم من أعبائه ومسؤولياته، لم ينقطع الرحبي عن التأليف والكتابة فأصدر مثلاً الكتب التالية: جبال، منازل الخطوة الأولى، سيرة المكان والطفولة، معجم الجحيم، يد في آخر العالم، حوار الأمكنة والوجوه، الجندي الذي رأى الطائر في نومه، مقبرة السلالة، قوس قزح الصحراء، الصيد في الظلام، أرق الصحراء، قطارات بولاق الدكرور، سألقي التحية على قراصنة ينتظرون الإبحار، حوارية نشيد الأعمى، حياة على عجل، رسائل في الشوق والفراغ، نسور لقمان الحكيم، من بحر العرب إلى بحر الصين، من الشرق إلى الغرب، سنجاب الشرق الأقصى، شجرة الفرصاد. هذا علمًا بأن مختارات من أعماله تمت ترجمتها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والهولندية والألمانية والبولندية.
كتب عنه فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية (3/1/2015): «لقد اختار منذ صباه أن يكون متمرّدًا على الصمت المنافق، فكان ما في قلبه على لسانه، لا يزال حتى هذه اللحظة كذلك وهو الذي يعرف أن مكانته في بلده هي حصيلة كدح يومي، عاشه بين المنافي وهو يحلم بالعدالة الاجتماعية. انتماؤه إلى الشعر لا ينفي حقيقة أنه اليوم واحد من أكبر كتاب النثر في الوطن العربي، وهو ما يجعله يشفق على شعره مثلما يشفق على بلده الذي وهبه مهنة العيش في حيوات متخيلة. لقد صنع سيف الرحبي مصيره بيديه. فارق السياسة يوم أدرك أنها مهنة العاجزين، غير أنه لم يستسلم لإغراءات الوظيفة وهو يعرف أنها الطريق الأرخص إلى الموت، حدثني عن حاسة البصر ذات مرة فقال (أسوأ ما يقع للمرء أن يكون غير قادر على القراءة). الرحبي قارئ من طراز خاص، كان متأملاً حياته قارئًا فيما كانت الكلمات تحك أصابعه».
وحينما سألته صحيفة الغد (18/8/2005) في حوار مفتوح عن مصدر مأساته وشعوره بالتيه الذي يميز أعماله أجاب إجابة يستشف منها مدى تأثير أماكن البدايات عليه. إذ قال: «هذا الشعور المأساوي بالوجود، بثقل الحياة والزمن، هو قدر المنفصل عن قيم الجماعة والقطيع، ويمكن الزعم أنني انفصلت عن هذه القيم بشكل مبكر مثل الكثير من أفراد جيلي بأماكن مختلفة، وهناك أيضا الاحساس الوجودي المدمر بمرور الزمن ومأساة هذا العبور، وهذا التغيير وهذا المحو والمحق بحق حلم في الكائن أو البشري، وهذا الشعور ربما يختلف من شخص إلى آخر. أتذكر دائما فضاءات المكان العماني الذي ولدت فيه وقصة الشطر الاول من طفولتي في منحدراته الصخرية والعنيفة. إن تلك الاضاءات والتضاريس في جبالها الجرداء الشاسعة والموحشة ربما تكون من المنابع الاساسية لهذا الشعور بمرارة الكائن واغترابه وانسحاقه أمام الزمن. وتذكرني أيضا بقدرة هذا الكائن وجبروته على الصمود رغم الطبيعة القاسية والظروف الصعبة، وفي قدرته أيضا على العيش والإنتاج والتكيف بهكذا ظروف».
ونختتم بمعلومة قرأتها في موقع «سبلة عمان» عن الرحبي مفادها أنه كانت لديه مشكلة دائمة مع المكتبة. ففي كل بلد يصل إليه يبدأ بتأسيس مكتبة خاصة به، وحينما يقرر الرحيل إلى بلد آخر لا يجد مفرًا من توزيع كتبه على معارفه وهو يتألم ويتحسر عليها.
المصدر: الأيام