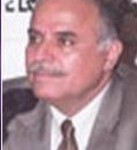شهدت السنوات القليلة الماضية تقدم العاهل التايلاندي الملك بهوميبون أدونياديت (هكذا يلفظ اسمه خلافًا لطريقة الكتابة) في السن وتراجع نشاطه، وإجراء أكثر من عملية جراحية له لفتح انسدادات في شرايين قلبه أو لمعالجته من التنمل الدائم لقدميه. وفي كل مرة كان السؤال المطروح هو حول مصير البلاد في حال غيابه عن المشهد، هو الذي اعتبر أطول ملوك تايلاند عهدًا، بل عميد ملوك العالم على الإطلاق.
وأسباب الخشية تكمن في أن ولي العهد الأمير «فاجيرالونغكورن» (64 عامًا) قد لا يستطيع ملء الفراغ ومواصلة دور والده بنفس القدر من الحكمة، وبعد النظر. فهو رغم مؤهلاته العسكرية (خريج الكلية الحربية في بيرث بأستراليا) وتلقيه دورات عسكرية إضافية متقدمة، ورغم مؤهلاته السياسية (خريج إمبريال كوليدج في لندن) لا يملك من سحر الشخصية، والاستقامة العائلية، والمواهب الفريدة، والتجارب الغنية، ما يمكنه من أن يكون صنوًا لأبيه. ورغم أن التايلانديين عمومًا يتجنبون الحديث علانية عن ذلك (احترامًا للعائلة المالكة، وأيضا خشية من العقوبة التي قد تصل إلى السجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 15 عامًا لكل من يسيء بالكتابة أو القول إلى الملك أو الملكة أو ولي العهد)، فإن ما لم يعد سرًا هو أنهم ينظرون إلى ولي العهد بحذر شديد بسبب كثرة مغامراته، ونزواته، وفشل زيجاته، وغير ذلك من الأمور التي لا تليق في عرفهم بمن يفترض أنه سيمثل الأمة، ويجسد هويتها الثقافية، ناهيك عما عرف عنه من حدة الطبع، والتي قد توقعه وتوقع الملكية معه في مشاكل مع الساسة.
والملكية في تايلاند فريدة من نوعها سواء لجهة تاريخها وتطورها، أو لجهة التقاليد التي تحكمها، والأدوار التي يضطلع بها الملك في الحياة العامة. إذ لها من التاريخ ما يقارب سبعة قرون شهدت خلالها عمليات تطوير وتحديث تدريجية على يد من توالوا على العرش، ولاسيما الملوك التسعة من سلالة «تشاكري» التي ينتمي إليها الملك «بهوميبون أدونياديت»، بحيث تحولت في النهاية إلى مؤسسة محترمة في الداخل والخارج وإلى عمود فقري لاستقرار البلاد، ووحدتها الوطنية، وسلامها الاجتماعي. أحد أبرز هذه التطورات ما حدث في عام 1932، الذي يؤرخ لبدء مرحلة الملكية الدستورية وانتهاء عهد طويل من الملكية المطلقة والحكم المركزي الشديد. ففي ذلك العام استجاب الملك «براجاديبوك» أو (راما السابع) للضغوط الشرسة التي مورست عليه من قبل النخب التايلاندية، وقبل على مضض استبدال الملكية المطلقة بأخرى دستورية.
غير أنه لم تمضِ على هذا التطور سوى فترة وجيزة حتى كان راما السابع – بسبب الوضع الجديد المقيد لصلاحياته، معطوفًا على أمور شخصية شبيهة بتلك التي أدت إلى تنازل الملك البريطاني «إدوارد الثامن» عن العرش – يضيق ذرعًا بالوضع ويتخذ قرارًا في عام 1935 بالتنازل عن الملك لابن أخيه «أناند ما هندون» أو (راما الثامن). وتمثل قصة هذا الأخير تراجيديا حزينة في تاريخ أسرة تشاكري الملكية التي حكمت تايلاند منذ عام 1782 ولاتزال تحكم حتى كتابة هذه المادة، وقدمت للبلاد تسعة من ملوكها. فقد ولد الأمير أناند في مدينة «هايدلبيرغ» الألمانية وعاش بها كل طفولته دون أن يرى موطنه الأصلي أو يتعرف على شعبه. وحينما نودي به ملكًا على البلاد لم يكن قد تجاوز سن العاشرة من العمر، كما لم يكن أنهى بعد دراسته. فتقرر إبقاؤه في ألمانيا وتأجيل مراسم تتويجه حتى بلوغه سن الرابعة عشرة. وهكذا عاد أناند إلى وطنه للمرة الأولى في عام 1938 ليضطر بعد أشهر معدودة من تتويجه إلى مغادرتها بسبب الحرب العالمية الثانية. ومع انتهاء الحرب في عام 1945 عاد الملك الشاب إلى عرشه، لكن ليصاب بعد عام واحد بطلق ناري عارض في رأسه من بندقية صيد، في حادثة لا يزال الكثير من الغموض يكتنفها، وليتوفى تاركًا العرش الذي لم يهنأ به طويلاً لشقيقه الأمير «بهوميبون». ولأن الأخير كان وقتها طالبًا في المرحلة الجامعية في سويسرا التي كان قد انتقل إليها مع والدته في أعقاب وفاة والده الأمير «ماهيدون» شابًا في الولايات المتحدة، فإن تتويجه تأخر لمدة أربعة أعوام (حتى 9 يونيو 1946)، وذلك من أجل أن ينهي الأمير دراسته في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة لوزان.
إن الملكية التايلاندية – لئن اتفقت مع باقي الملكيات الدستورية في كون صاحبها يملك ولا يحكم، فإنها تختلف معها في أن للملك ثلاثة حقوق أساسية يمكنه من خلالها إضفاء مرئياته على شؤون البلاد. هذه الحقوق هي: الحق في إسداء المشورة إلى رأس الحكومة، والحق في تحذيره، والحق في تشجيعه. وقد استخدم الملك بهوميبون هذه الحقوق بمهارة فائقة أثناء المنعطفات والمآزق الصعبة التي واجهت بلاده خلال العقود التي جلس فيها على العرش. ففي الخمسينات مثلا انتصر الملك للجنرال «ساريت داناراجاتا» الذي هدد بالقيام بانقلاب ضد حكومة الفيلد مارشال «بيبولسونغرام»، وذلك بإعلان الأحكام العرفية في البلاد بعد ساعات من استيلاء الجنرال ساريت على السلطة، وتعيين الأخير حاكمًا عسكريًا. وقد اختلفت الآراء حول علاقة الملك بالجنرال ساريت وأيهما استخدم الآخر للوصول إلى أغراض ما. أما في الستينات مثلاً، وتحديدًا عندما رفضت الحكومة العسكرية قبول قرار لمحكمة العدل الدولية لصالح كمبوديا ضد تايلاند في خلاف حدودي، تدخل الملك، وأقنعها بالموافقة، الأمر الذي جنب البلاد الانتقادات، وحمى سمعتها الدولية. وفي عام 1973 الذي شهد ثورة طلابية ضخمة ضد حكومة «تانوم كيتيكا تشورن» العسكرية، سقط خلالها أكثر من مائة متظاهر برصاص الجيش، لم يستطع الملك السكوت وتدخل مستقبلاً نشطاء الديمقراطية من طلبة الجامعات في قصره، وطالبًا من رئيس الحكومة، ونائبه مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة، وعاهدًا بمسؤولية رئاسة الحكومة إلى الدكتور «ساينا دارماساكي» من جامعة «تاماسات» الشهيرة. أما حينما قام نفر من عقداء الجيش بانقلاب في عام 1981 على رئيس الحكومة الجنرال «بريم تينسولانوند» احتجاجًا على اعتداله ومرونته، فقد كان خروج العائلة المالكة من بانكوك والتحاقها بالجنرال المخلوع في شمال شرق البلاد مؤشرًا على امتعاض الملك، وعملاً كافيًا لإحباط الانقلاب. إلى ما سبق من الأمثلة، لايزال التايلانديون يتذكرون كيف أن الملك لم يكتف بوضع أسس الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي – قبل أن يحاول العسكر في 23 فبراير 1991 أن يعودوا بالبلاد إلى الديكتاتورية – بل حمى البلاد والشعب من حرب أهلية حينما احتل المتظاهرون من نشطاء الديمقراطية شوارع وساحات العاصمة في مايو 1992، ردًا على قيام حكومة الجنرال «سوتشيندا كرابرايون» العسكرية باستخدام الرصاص الحي والدبابات ضد المدنيين العزل. وقتها استدعى الملك رئيس حكومته، وزعيم الحركة الاحتجاجية الجنرال المتقاعد «تشاملونغ سريماوانغ»، إلى قصره، فجاءاه زاحفين على أقدامهما ليسمعا منه أمام كاميرات التلفزة المحلية والعالمية توبيخًا على ما آلت إليه الأحوال، ودعوة لإنهاء الأزمة. فكانت هذه الخطوة إشارة على عدم رضا الملك عن الحكومة التي بادر زعيمها إلى الاستقالة فورًا، مفسحًا الطريق أمام تدشين عهد ديمقراطي جديد.
وتدين الملكية في تايلاند بالكثير للملك بهوميبون، المولود في عام 1927 في مستشفى «مونت أوبورن» بمدينة كمبريدج في ولاية ماساتشوسيت الأمريكية حيث كان أبوه وأمه يدرسان الطب في جامعة هارفارد وكلية سومونس على التوالي. فهو بذكائه، وبعد نظره واحترامه للدستور، وتواصله المستمر مع العامة، من خلال زياراته الميدانية في طول البلاد وعرضها للاطلاع على أحوال العامة والاستماع إلى ملاحظاتهم، أكسبها وهجًا واحترامًا شعبيًا قلما تنافسه فيه الملكيات الأخرى، وأضفى عليها بعدًا إنسانيًا بحيث صار ينظر إليها كمصباح مرشد للأمة، وكمؤسسة تعمل من أجل رفاهية ونهضة الشعب، لا من أجل إخضاعه وحكمه.
حدث كل هذا رغم أن الرجل لم يعد ليكون ملكًا. فاختياره جاء مصادفة، كما أسلفنا، وذلك في أعقاب مقتل شقيقه الأكبر الملك أناندا في عام 1946 في حادث مأساوي غامض وهو لم يزل في ريعان شبابه. ويستمد الملك بهوميبون، جزءًا من احترام شعبه له من كونه حارس الديانة البوذية التي يدين بها غالبية السكان، لكنه يستمد الجزء الآخر من نبوغه وتميزه في جملة من المعارف والعلوم، على اعتبار أن التميز والفرادة رديفان لصفة الملك. ففضلاً على إطلاعه الواسع في مجال السياسة والقانون والعلاقات الدولية، يولي الملك اهتمامًا خاصًا بعلوم البيئة وشؤونها إلى الدرجة التي حول معها جزءًا من مكتبة القصر الملكي وقاعاته للأبحاث المتعلقة بهذا المجال. إلى ذلك فهو عازف ماهر على آلة السكسافون وله مؤلفات موسيقية كثيرة في فن الجاز – كان أول آسيوي يحصل على عضوية أكاديمية فيينا للفنون الموسيقية في سن الثانية والثلاثين – وهو ايضا كاتب رواية باللغات التايلاندية والإنجليزية والفرنسية، وخبير في فنون التصوير الفوتوغرافي وتقنياته، وفنان تشكيلي مبدع.
أما رياضيًا، فقد شغف هو وشقيقه «أناند» منذ صغرهما بهواية الرماية. لكن بهوميبون هجرها إلى هواية تصميم القوارب الشراعية والمشاركة في مسابقاتها (حصل هو وابنته الكبرى على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الرياضية الجنوب شرق آسيوية في بانكوك في عام 1967)
عوامل كثيرة لعبت دورًا في تعزيز شعبية بهوميبون الطاغية وشخصيته الآسرة التي جمعت ما بين عبقرية العلماء، ودهاء الساسة، وتواضع البسطاء، ورقة الفنانين. أبرزنا بعض هذه العوامل فيما تقدم، فيما البعض الآخر ارتبط بإيلائه اهتمامًا خاصًا وفريدًا منذ شبابه بعملية تنمية قدرات وأحوال مواطنيه الأقل دخلاً، وذلك وفق فلسفة قامت على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بمعنى الإدارة الصحيحة والفعالة لموارد محدودة من أجل خلق أكبر قدر من المنفعة للجميع. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تجاوز الملك جهود حكومته ومؤسساتها، فتبنى شخصيًا آلاف البرامج والمشاريع التنموية الصغيرة وأنفق عليها من مخصصاته الملكية، وذلك في مجالات مثل تنمية الاقتصاد الريفي، وحماية الغابات ومصائد الأسماك، وتطوير آليات الري، ومكافحة الأمراض الزراعية، وإحلال المحاصيل النافعة مكان زراعة الأفيون والمخدرات، وتعليم المهارات الجديدة.
وقبل أن يداهمه العجز ويتقدم في السن، كان بهوميبون الذي حق له أن يحتل مكانة في قلوب التايلانديين تضاهي مكانة (راما الخامس) أو الملك الأكثر ذكرًا في تاريخ تايلاند بسبب ما تميز به عهده الطويل (1868 – 1910)، كان ينطلق على مدار العام من قصوره الأربعة الواقعة في زوايا البلاد المتباعدة ليقطع آلاف الأميال في زيارات ميدانية حية لتدشين المشاريع الخيرية والإنسانية والبرامج الهادفة إلى مساعدة الفلاحين والمهمشين، وليقحم نفسه في مشاكل هؤلاء ومطالبهم التي عادة ما كانت تدور حول الري، والحصاد، والقروض الزراعية، وتسويق المحاصيل، وشبكات الطرق والمياه والكهرباء، ثم ليرفع بما سمعه تقارير وتوصيات عاجلة إلى الحكومة في بانكوك. ومما دأب بهوميبون على فعله أيضا، معاودة زيارة تلك المناطق لمراقبة وفحص ما دشنه أو أوصى بتحقيقه، مفضلاً هذا العمل على السفر إلى الخارج في زيارات رسمية حافلة بالرسميات والمآدب وحفلات الاستقبال، حتى قيل أن العاهل التايلاندي هو أقل ملوك وساسة العالم سفرًا. وهذا صحيح! إذ لم يعرف عنه خلال عقود من حكمه أنه سافر إلى خارج وطنه باستثناء مرة واحدة، وكانت وجهته العاصمة اللاوسية «فينتيان» لحضور حفل افتتاح جسر يربط البلدين عبر نهر «الميكونغ»، وذلك تعبيرًا عن رغبته في توثيق العلاقات مع هذا الجار المشاكس، القريب من تايلاند جغرافيًا وثقافيًا واثنيا، والبعيد عنها أيديولوجيا. بل حتى حينما ساءت صحته وتقرر إجراء عملية جراحية دقيقة له في القلب، رفض أن يغادر للعلاج في الخارج مفضلاً أن يعالج في الداخل على أيدي أطباء من مواطنيه.
كان أول مرة يرى فيها بهوميبون وطنه هو في عام 1928، حينما جاء برفقة والدته الأميرة «موم سنغوان». وقتها التحق لفترة وجيزة بمدرسة «ماتير داي» في بانكوك، قبل أن تأخذه أمه في عام 1933 معها إلى سويسرا حيث درس في «المدرسة السويسرية الفرنسية الجديدة» في لوزان.
أما زيارته الثانية لوطنه فقد كانت في عام 1938 لحضور مراسم تتويج شقيقه، والتي أعقبتها عودته إلى سويسرا لإكمال تعليمه، والحصول على الدبلوم العالي في آداب اللغات الفرنسية واللاتينية واليونانية. وبحلول عام 1945 وتوقف الحرب العالمية الثانية كان بهوميبون قد التحق بجامعة لوزان لدراسة العلوم. هذا التخصص الذي هجره لاحقًا – حينما نودي به ملكًا على تايلاند – لدراسة القانون والسياسة في الجامعة ذاتها، وذلك من باب أن يكون جديرًا بإدارة بلاده.
ومما يذكر عن سيرة الرجل أثناء فترة دراسته في لوزان، أنه كان كثير التردد على باريس القريبة. وفي الأخيرة عشق وتعرف على الأميرة «سيريكيت» ذات الخمسة عشر ربيعًا، ابنة أحد أولاد أعمامه المباشرين، والتي كانت تعيش وقتذاك مع والدها، سفير تايلاند في باريس. وفي باريس أيضا، أو قريبا منها، تشاء الأقدار أن يتعرض بهوميبون في 4 أكتوبر 1948 لحادث سير خطير أثناء قيادته لسيارته من طراز «فيات توبولينو» على طريق لوزان – باريس، فيصاب بكسور في ظهره، بل ويفقد إحدى عينه، من جراء اصطدامه بقوة بمؤخرة شاحنة. ومنذ تلك الحادثة الرهيبة عاش الملك بعين زجاجية وأخرى طبيعية.
وأثناء وجوده في المستشفى في لوزان للعلاج، كانت الأميرة سيريكيت تعاوده باستمرار، فتعرفت هناك على والدته التي طلبت منها أن تنتقل إلى مدرسة داخلية في لوزان كي تكون قريبة من ابنها. وقد وجدت الأميرة في هذا الطلب فرصة لكي تتعرف أكثر على زوج المستقبل، فقبلته. وفي 28 ابريل 1950، وقبل أسبوع واحد فقط من تتويجه رسميًا، عقد بهوميبون قرانه الملكي على الأميرة سيريكيت، التي ستصبح ملكة لتايلاند، ولاحقًا أما لولي العهد وأخواته الأربعة.
ومن ضمن تدخلات الملك بهوميبون في سياسة الحكم في بلاده، عدا عن تلك التي تطرقنا إليها آنفًا، ما حدث في الفترة ما بين عامي 2005 و2006. فقبل إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل 2006 رأت بعض الأحزاب الخائفة على حظوظها الانتخابية في ظل ما كان يتمتع به رئيس الوزراء القوي «تاكسين شيناواترا» من نفوذ وشعبية، أن تلجأ إلى الملك بهوميبون طالبة منه التدخل وتعيين رئيس حكومة ومجلس وزراء. غير أن رد الملك في 26 ابريل 2006 جاء مخيبًا لآمالهم، حيث أكد على أن تعيين رئيس للحكومة بقرار ملكي أمر غير ديمقراطي، فضلاً عن أنه غير منطقي.
ولهذا السبب قاطعت المعارضة انتخابات 2006، فيما خاضها ونجح فيها حزب «التايلانديون يحبون التايلانديين» بزعامة رجل البوليس السابق، وتايكون المال والأعمال «تاكسين شيناواترا»، الذي أعرب من خلال محطات التلفزة بعيد لقاء له مع الملك، أنه قرر أن يترك السياسة لبعض الوقت، رغم أنه لم يكن يعني ما يقول!
وقد راجت تكهنات كثيرة عما دار بين شيناواترا والملك خلال خلوتهما التي انتهت بالنهاية المشار إليها، خصوصًا وأن تايلاند كانت تسودها وقتذاك إشاعات مفادها أن شيناواترا كان قد خطط مع الزعيم السابق للحزب الشيوعي التايلاندي للإطاحة بالملكية والاستيلاء على السلطة. تلك الإشاعات التي لم يقم عليها دليل، ونفاها شيناواترا ورموز حزبه نفيًا قاطعًا.
ونظرًا لأن المقاطعين للانتخابات شككوا في نزاهتها، فإن الملك، ولأول مرة، ظهر على شاشات التلفزة المحلية ليدعو السلطة القضائية لتحمل مسؤوليتها، وحل الأزمة السياسية الناشئة عن انتخابات أبريل 2006. وبالفعل لبى القضاة دعوة الملك، واعتبروا نتائج الانتخابات باطلة مع دعوتهم إلى إجراء انتخابات جديدة في 15 أكتوبر 2006. وعلى إثر ذلك، وفي ظاهرة غير مسبوقة، أصدر الملك مرسومًا ملكيًا في يوم الانتخابات يطالب فيه كل المعنيين بإجراء انتخابات نظيفة ونزيهة، فيما كان الجنرال المتقاعد «بريم تينسولانوند» رئيس مجلس الخاصة الملكية يعلن في حفل تخرج في الأكاديمية الملكية العسكرية «أن العسكر يجب أن يخدموا الملك، لا الحكومة».
غير أن الجيش بقيادة قائده الجنرال «سونتي بونياراتغلين» استبق الأمور، فقام في 19 سبتمبر بانقلاب عسكري أبيض خلع فيه حكومة شيناواترا، متهما الأخير بجملة من الاتهامات على رأسها العمل ضد النظام الملكي. ومما قام به الجيش أيضا إعلانه ولاءه التام للملكية، وفرضه للأحكام العرفية، وتجميده العمل بمواد الدستور، وإلغائه لانتخابات أكتوبر المقررة، مع وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين في غضون عام واحد. وبعد يوم واحد من هذا التطور أعلن الملك عن دعمه التام ومساندته لحركة الجيش، الأمر الذي أثار موجة من اللغط حول دور الملك فيما وقع. حيث قال بعض المراقبين أن الانقلاب حدث بعلم وتخطيط الملك، فيما قال آخرون – وعلى رأسهم شيناواترا – أن الشخصية التي خططت ووقفت خلف الانقلاب هي الجنرال «بريم تينسولانوند».
وبغض النظر عمن خطط وأيد الانقلاب ورموزه، فإن الحدث حظي بتأييد الكثيرين، ولا سيما في العاصمة، ممن التفوا حول دبابات الجيش وأمطروا جنوده بالورود، وذلك في ظاهرة معاكسة لما يجري في البلدان الأخرى وقت وقوع الانقلابات العسكرية.
واستمر الملك رغم متاعبه الصحية في لعب دور المرشد والناصح، فنراه في 24 مايو 2007 (أي قبل نحو أسبوع من صدور توصيات وأحكام المنبر الدستوري الذي أسس للنظر في طعون التزوير ضد حزب شيناواترا وخصومه، والذي وضع عقوبات بالحل لكل حزب يثبت تورطه في التزوير، وعقوبات بالمنع من الاشتغال بالسياسة لمدة خمس سنوات لكل فرد ضالع في مثل تلك الأعمال) يلقي خطابا نادرا أمام المحكمة الإدارية العليا التي كان رئيسها رئيسًا في الوقت نفسه للمنبر الدستوري، ويقول ناصحا: إن عليكم مسئولية كبيرة لإنقاذ الأمة من الانهيار، وإن الأمة بحاجة إلى أحزابها السياسية!
وبهذه العبارة المقتضبة، جعل الملك المراقبين في حيرة عما كان يود إيصاله بالضبط. فهل مثلاً كان يحذر من مغبة حل أكبر حزبين في البلاد لما سينطوي على ذلك من تذمر شعبي وربما مصادمات؟ أم كان يحذر القضاة من الحلول التوافقية ضد مصلحة الأمة؟
الحقيقة أن الملك بتلك العبارة أراد أن يتفادى الظهور بمظهر المنحاز إلى هذه الجهة أو تلك، فانحيازه إلى أي منهما، أو الحكم ضد أي منهما، خطر على وحدة الأمة، ودور الملكية المفترض هو أن تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الأمة السياسية والثقافية والعرقية.
والحال أنه في تاريخ الأمم والشعوب ملوك تضيق الصفحات بذكر مآثرهم ووصف ما أغدقته عليهم شعوبهم من مشاعر الحب والولاء وهالات التبجيل. لكن لم يسبق لأحدهم أن حظي من شعبه بمثل ما حظي به الملك «بهوميبون أدونياديت» من مكانة سامية في أعين وأفئدة التايلانديين على مختلف فئاتهم وطبقاتهم وانتماءاتهم الفكرية منذ اعتلائه عرش مملكة سيام في عام 1946.
فهل سيحظى ملك تايلاند الجديد بنفس المكانة التي كانت لوالده في قلوب التايلانديين؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
المصدر: الأيام