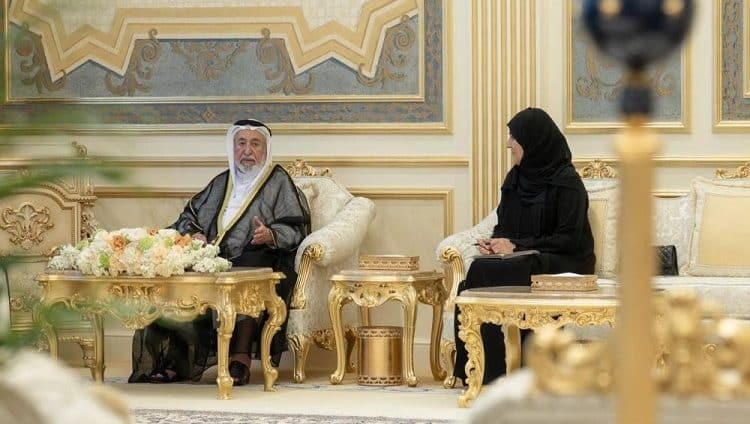لم يَدُر في خُلدي وأنا أجول في شوارع إسطنبول الجميلة و ألتقط الصور التذكارية في ساحة تقسيم الشهيرة منذ حوالي الأسبوعين أن المكان الذي أقف فيه الآن سُرعانَ ما سيَعُجُّ بحشود غاضبة من الأتراك الساخطين على حكومتهم والمطالبين بإقالتها في صورة تستدعي تلقائيًا تلك الاضطرابات التي مرّت وما زالت تمر بها بعض دول المنطقة والتي انتهت في بعض الحالات إلى قلب أنظمة الحكم فيها كماحدث في مصر وليبيا واليمن. بدت الأوضاع خلال زيارتي لإسطنبول هادئة للغاية ولم تكن هناك أية إرهاصات تُنبئ بغضبة أواحتجاجات قادمة…. ناهيك عن أن تُحدث شرارتها الأولى “حديقة”.
الأسباب التي منعت معظم المتابعين للمشهد التركي من التنبؤ بإمكانية حدوث مثل هذا التحول المفاجئ في الوضع السياسي هي الموشرات الإيجابية التي تحققت للاقتصاد التركي منذ حوالي عقد من الزمان. فعلى عكس دول “الربيع العربي” التي شهدت تدهورًا مزمنًا في أوضاعها الاقتصادية خلال الفترة التي سبقت انتفاضاتها الشعبية، كان الاقتصاد التركي يصعد بثبات ويحقق نجاحات اقتصادية باهرة رغم وقوعه ضمن منطقة زلازل سياسية واقتصادية. ففي الغرب تجاورها دول أوروبية أنهكتها الأزمات الاقتصادية الأخيرة، ومن الشمال والشرق والجنوب تحده دول تتآكلها الحروب والاضطرابات السياسية.
كان من اللافت والمثير للإعجاب حقًا أن يبرز من وسط هذه العواصف والقلاقل السياسية والاقتصادية المحيطة اقتصاد ناشئٌ بدأ في الصعود سريعًا وبخطوات ثابتة، بحيث لم يكن من الصعب عليّ أو علي أي زائر آخر أن يلمس علامات الازدهار الاقتصادي التي بدت جليّة في كل زاوية من زوايا البلد. ذهبت في رحلتي تلك مُحملّة بكثير من الأسئلة، وعدت منها بأسئلة أكثر وآعمق من قبيل: كيف حدث هذا كله، ومتى وبفعل من؟.. وبعد بحث وقراءة مستفيضة، أستطيع أن ألخّص لكم ما يلي:
بدأ الاقتصاد التركي بالصعود بشكل لافت منذ العام ٢٠٠٢ بعد أزمة اقتصادية ومصرفية حادة استدعت تدخل صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد الذي كان على شفير الهاوية آنذاك. و بعد سلسلة من الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وفريقه الاقتصادي والتي ركزت على استراتيجية وأهداف بعيدة المدى، تمكن الاقتصاد التركي من استعادة عافيته وبدأ تدريجيًا يحقق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى حوالي ٩.٢٪ في عام ٢٠١٠ و ٨.٥٪ في عام ٢٠١١ مما جعله واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا والعالم. وقد رافق النمو المرتفع مستويات عالية من خلق الوظائف واستثمار قوي في البنية التحتية والتعليم والصحة. كما أنه خلال العقد الماضي انخفضت مستويات الفقر وتقلصت الفروقات في الدخل، وازدهر قطاع السياحة في البلد لتصبح تركيا واحدة من أهم وجهات السفر على مستوى العالم حيث قُدّر عدد الزوار الذين استقبلتهم في عام ٢٠١٢ وحده أكثر من ٣٥ مليون زائر.
اليوم تُعتبر تركيا واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مذ تم إنشاؤها في عام ١٩٦١، وهي أيضًا عضوفي مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم. وتُعد تركيا اليوم من آبرز المنتجين في العالم للمنتجات الزراعية، والمنسوجات، ومواد البناء ومعدات النقل والالكترونيات وتقنية المعلومات، مدعومة ببنية تحتية متميزة وشبكات طرق وسكك حديدية على أعلى المستويات. وقد استحقت تركيا نتيجة هذه الإنجازات الاقتصادية تحسنًا مستمرًا في تصنيفها الإئتماني بحيث أصبحت اليوم تحوز على ثقة المستثمرين على عكس جاراتها من الدول الأوروبية التي ترزح تحت وطأة أوضاع اقتصادية متردية. ولا نبالغ إن قلنا بأنها أصبحت اليوم “رجل أوروبا المعافى” في وسط مليء بالبلدان المريضة!
نتيجةً لما تقدّم، جاءت أخبار المظاهرات والاحتجاجات المتصاعدة في الشارع التركي صادمة للكثيرين. ففي حين كنا نعتقد أن الشعب — أي شعب في الدنيا — لا يهمه سوى الحصول على حياة كريمة يضمن فيها قوت يومه وتتوفر له أبسط مقومات الحياة (ومن الواضح جدًا أن المواطن التركي نال أكثر من ذلك بكثير)، تأتي هذه الاحتجاجات لتثبت لنا أن هناك أمورًا أخرى لا تقل أهمية عن قوت اليوم.
بالنسبة للشارع التركي، أو على الأقل الجزء العلماني منه، تعتبر حرية الرأي والتعبير والممارسات الشخصية أمورًا لا تقل أهمية عن تحسن الظروف الاقتصادية. حيث بدأ العلمانيون يتململون من التدخل المتزايد للحكومة في بعض تفاصيل الحياة اليومية متهمين الحزب الحاكم ذو الخلفية الدينية بمحاولة “أسلمة” الدولة ذات النظام العلماني واصفين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ب”الخليفة” و “السلطان الجديد”!
لستُ هنا بوارد تحليل المشهد السياسي التركي رغم أهميته في التنبؤ بمستقبل الازدهار الاقتصادي، حيث من المعروف أن الاستقرار السياسي في أي دولة هو شرط مسبق لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي فيها. إلا أني أؤمن بأن ما تحقق في تركيا حتى اليوم هي إنجازات اقتصادية رائعة بغض النظر عن آيديولوجية الساسة الذين عملوا على تحقيقها و أنها جديرة بالإشادة حتى من جانب أولئك الذين يعارضون سياسات الحكومة. المهم بالنسبة لتركيا اليوم هو العمل على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت لها مهما كلّف الأمر و العمل على سرعة إخراج البلاد من هذه الأزمة قبل أن تستفحل و تكون لها تداعياتها الخطيرة التي قد تكلّف البلاد غاليًا إن لم تُعالج في الوقت المناسب.
خاص لـ ( الهتلان بوست )