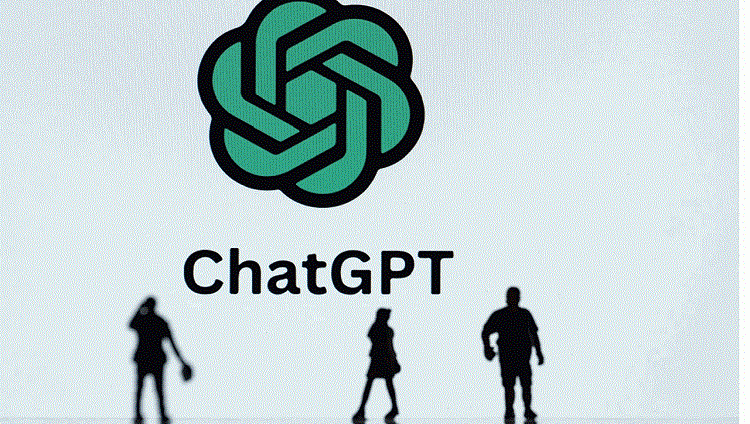أيام وليالي شهر رمضان في الأمس البعيد بالسعودية، أصبحت ذكريات تسرد وقصصا تحكى، يحن لها من عاشها في طفولته رغم ما بها من شظف في العيش وضيق في ذات اليد وصعوبة في التواصل للتبليغ عن حلول الشهر الكريم لدى الصائمين من أهل تلك القرى النائية.
وفي ندوة عنوانها «رمضان في ذاكرتهم»، أقامها النادي الأدبي بالرياض أخيرا، وشارك فيها عبد الرحيم الأحمدي (المدينة)، ومنصور العمرو (الرياض)، ورجاء عبد القادر حسين (مكة المكرمة)، وأدارها محمد القشعمي، أعادت تلك الذكريات بحلوها ومرها.
عبد الرحيم الأحمدي الذي عاش بعض طفولته في المدينة قبل أن يكملها في مكة، حيث جاء في الأصل من وادي الصفرا وهي منطقة بين المدينة وينبع يقول: «أول ما يقرب شهر رمضان يبدأ الإخبار عنه، حيث ينتظره الناس عن طريق البريد ويخبرون كل مركز يمرون عليه».
وحين وصول الخبر، تطلق البنادق، وتتسلسل بإطلاق النار من منطقة إلى أخرى حتى يعرف الناس جميعا أن هلال رمضان هل وما أن ينتصف الليل تجد جميع المناطق بين المدينة وينبع قد علموا بدخول الشهر.
ووفق الأحمدي، كان رمضان يحل في أيام الصيف وشدة الحرارة ويصادف موسم جني الرطب وعمل «القلايد» وهي بلح قبل أن يصبح رطبا يجمع من نخل معين ويطبخ مع الملح والكركم ليعطي الأخير لونا ويحافظ عليه، أما الملح فهو واق وبمثابة البسترة ثم يجفف البلح المقلي في الظل.
وفي الجانب الآخر تنسج النساء الحبال، من ليف النخل حتى ينظمنه فيما يسمى بـ«القلايد»، وهو موجود عند باعة المكسرات و«القلايد» تدخل في طبخ حلوى معينة تسمى «الدبيانة» وهي مزيج من قمر الدين والتين الجاف والبلح وبعض المكسرات، حيث يغلى، ويشتريه الحجاج كهداية عند عودتهم لأهلهم وبلادهم.
وفي الصباح الباكر من كل يوم في رمضان وفق الأحمدي، يستيقظ الناس مبكرا ويجنون هذا البلح ويمشون ليغتسلوا في العيون الحالية، ويجلسون قرب الماء لتخفيف حرارة النهار وإذا صلوا الظهر بللوا «الشراشف» والتحفوها فناموا، حيث كانت بمثابة مكيف يلطف حرارة الجو، وكانت النساء يصنعن «القلايد» ويتولين الطبخ للبلح و«دشره» للتجفيف.
بين الصلاة والصلاة يقرأ الصائمون القرآن، حتى يحين وقت الإفطار وهو عبارة عن تمر وقهوة ليس إلا، لأنه موائد المتنوعة، مشيرا إلى أنه في ذلك الزمان، تقرأ في التراويح سورة «التكاثر» و«الإخلاص» فقط حتى يوتروا، وليس هناك مبالغة في التبتل في رمضان ولكن يزيد التصدق على المستحقين.
وبعد أداء صلاة العشاء يقرأ المصلون جزءا من القرآن ثم ينصرفون إلى مجلس القهوة حيث الرطب والتمر، وبعدها ينطلق المنتدى الشعري والروايات والحديث ثم ينامون وفي السحور ويتناولون إحدى تفريعات القمح كـ«الرشيشة» ويعني «الدريش» أو القمح المجروش، أما في ليلة 27 من رمضان يتناولون السمك المجفف باعتباره سنة نبوية.
وأما العيد يخبر عنه كما يخبر عن حلول رمضان، وقبل ذلك يجهز الرماة ملح البارود يخلط ببعض الفحم وبعض المواد الأخرى حتى يتشكل ملح خاص يستخدم في رصاص البنادق لتضرب بها في الهواء إيذانا بتحديد يوم العيد.
وفي صباح العيد تخرج الناس إلى المصلى ويكون عادة بين القرى في مكان وسيع من كثبان الرمل وفي هذا اليوم يجهزون ذبيحة العيد، والملابس والتي ينتظرها الأطفال والنساء من العيد إلى العيد لأنه كسوة العام وأغلبها من «البستر» أو «التوت» ويكون في أغلبها من الملابس الحمراء أو الصفراء التي يسمونها الملا وتعمل النساء في تطريز هذه الملابس.
بعد ذلك يتعايد الناس في المصلى ثم يتعايدون بين المساء وتطلق البنادق ويذبح الذي يقع عليه الاختيار الذبيحة، لمدة ثلاثة أيام والاحتفالات تكون بالرمي على الأهداف والرقص بالسيوف، والتباري بالرماية.
محمد القشعمي، الذي جاء إلى الرياض منذ عام 1370 هجرية، لا تزال ذكريات طفولته في رمضان في مسقط رأسه منطقة الزلفي راسخة في ذهنه. ويذكر أن الحجازيين قبل رمضان، يقولون: «نشرب من وراء الزير» ويزيد: «ونحن في الزلفي نقول تحت تصنع من جلد الغنم قربة ونشرب التنقيط في غفلة الصائمين»، وهو يرسم بيئة الإنسان الصائم في ذلك المكان لتتخيل.
يقول القشعمي: «أتذكر وأنا طفل لم يتجاوز الثالثة أو الرابعة بعد كنا فرح بمجيء رمضان لأنه على الأقل يعني أن هناك ما يؤكل أو يطبخ ووقتها المواصلات غير موجودة ما عدا الحيوانات لأن السيارات لا تصل تلك القرى التي تحيط بها الرمال على مسافات بعيدة. وفي تلك القرى، كان يزرع فيها النخيل وقليل من الخضراوات كالقرع والقمح، «أما بقية الأيام لا تذكر أننا أكلنا حتى شبعنا من الموجود من التمر، ونتذكر أن صيفية كاملة كانت تعتمد القرية فيها على القرع والماء فقط».
وقال:«عمتي كانت تقول إن التمر به سراوة وتمنعنا أن نفتحه لئلا نرى السوس فنأكلها بسوسها وبسراوتها وجراثيمها وغيره وتحذرنا بأنها تدعو وتقول الله يكشف من كشف ستري، وإذا لم نشبع نبلع فصوص التمر حتى لا يتعرض الحلق».
ولفت إلى الراديو كأحدث وسيلة للتواصل ومعرفة شهر رمضان لم يدخل الزلفي إلا على يد «محمود البدر» قبل أن ينتقل إلى الرياض منذ 60 عاما هو أول من أدخل الراديو للمنطقة.
وقال القشعمي: «الخبر عن حلول شهر رمضان، لا يأتي إلا عن طريق برقية في المجمعة فقط، في منتصف الليل حيث يرسلون سيارة للزلفي بأن يوم غد رمضان أو غد عيد فيقومون بإضاءة سراج ويعلقونه في أعلى المنارة ولكن القرى الثانية يصلهم الخبر بعد الظهر أو بعد العصر، إذا كان رمضان أو عيدا مثلا».
رجاء حسين وهي أديبة وشاعرة ومؤلفة من مكة، تروي ذكرياتها في رمضان في هذه البقعة، من خلال قصتها مع عمتها «منة»، وتقول: «ستي منة في الروشان وهي عمتي واسمها مريم، حينما تضاء الفوانيس وتلمع النحاس وتزيد حركة (السقا) بزفة ذات جماليات اعلمي أن رمضان على الأبواب».
وزادت: «عمتي منة كانت تجلس في (مهبتها) وهي مروحتها في الروشان في العصاري على مدى سنوات طويلة لتتفرج على الغادي والقادم وعلى راعي المنفوش وبائعي الأشياء الباردة وكان هناك ما يسمى بالتوت البارد وكانت لبرودته نكهة خاصة عند تناول تحت غيظ حر مكة».
ووفق حسين، كانت البيوت في مكة، عبارة عن ديوان وهو المقعد الذي تدار فيه الأمور التجارية، والسلطة وهو مدخل كان جناح في البيت وهو المجلس بكسر الميم هو المجلس الآن، مشيرة إلى أن البيت كان يسمى الـ«عزلة» في مكة، مشيرة إلى هذا الشكل من المكونات، يعد ملمحا من ملامح رمضان في ذلك الزمان البعيد.
ويمثل المجلس موقعا لمناقشة أمور الاقتصاد والتربية، مبينة أن له الفضل في بلورة الكثير من الشخصيات التي ساهمت في بناء السعودية، مشيرة إلى أنه صقلهم بأصول التربية والتعليم وثقافة الحوار، بما في ذلك برتوكول تناول الطعام واحترام الكبار إلى آخره وتصف المجلس في رمضان بما يسمى بـ«المركاز»، يعني انتظام كل العائلة في جلسة كبيرة جدا تضم الكبار والصغار وتعد فيها الشاي ويستمع فيها للحديث عن حركة التجارة أو الطوافة، فضلا عن العادات والتربية، كما لا تخلو جلساته من أناشيد الأطفال والاجتماعيات.
وللمركاز أيضا دور في حل المشكلات، «لا نسمع سيرة طلاق لأنه يصلح ذات البين، في ذلك الزمان لا نرى شرطيا أو عسكريا لأن هيبة العائلة كانت مسيطرة على الوضع».
وأضافت: «كنا نسمع صوت المدفع عند أذان المغرب وعند السحور، وهناك بعض الأكلات المشهورة، مثل (شربة الحب) و(السمبوسة) وكان التكافل جميلا جدا فالحارة لا تجد فيها عزلة كبار المطوفين أو شيوخ المطوفين وكانت فيها بيوت ولاية وفقراء ولكن لم نحس بهذه الفوارق أبدا».
منصور العمرو الذي ترجع جذوره إلى عنيزة حيث أينع في المدينة، يحكي أن الاستعداد لرمضان في المدينة المنورة، يبدأ من شهر شعبان بما يسمى بالشعبنة وهي الخروج إلى المزارع والبساتين وأطراف المدينة على مدى يومين أو أكثر وتجهيز الهدايا وتجهيز البيت والأثاث وتنظيف وتجديده من عشرة شعبان وتخرج السجادات والجلائد وينظف بجريد النخيل وتغسل على مكان مرتفع وتنزل الماء في مكان منخفض. ووفق العمرو، يميز رمضان في ذلك الزمان شرب الماء من «الأزيار»، والذي يعد متعة فيما تنظف ربة البيت الزير وهناك حجار صغيرة تستخدم فيها وتبخر بـ«المستكة» وتبقى رائحة المسكتة مدة طويلة تستمر إلى ما بعد رمضان كأنها طعم في الماء.
في منتصف شعبان هناك نشاط للأطفال بشكل معين، ينشد فيه «سيدي شاهين ما شبيت» ويؤتى من الروشان يأتون بالحلوى و«الفشار»، مبينا أن رمضان يعلن عنه في المدينة بضرب المدافع حيث كان في جبل سد من الجهة الشمالية الغربية من المسجد الحرام قبل التوسعة الأخيرة، وذلك قبل انتشار استخدام المذياع في منتصف الثمانيات، بعد انتشار الراديوهات الصغيرة.
قال العمرو «كنا نطلع على سطح البيت وننظر إلى المنارة الرئيسة وهي مجاورة للقبة الخضراء كان عليها مصباح أحمر فمجرد إضاءته ننتقل بأنظارنا نحو الجهة الغربية لضرب المدفع عند الإفطار، وكان في المسد أربعة مآذن تستخدم فيها مكبرات الصوت، وتبدو كأنها أربعة مساجد بأصوات شجية مؤثرة، وكانوا يحرصون على الأذان من أسرة عثمان آل بخاري وإخوانه».
وذهب العمرو إلى أن الصيام في رمضان، ارتبط بالتمر كعبادة وكسنة، مبينا أن موسم الرطب في المدينة كان يختلف ما هو عليه الآن في البداية، حيث كان هناك نوع يسمى الجبيلي ومعروف نخلته تثمر مرتين في الموسم وهناك نوع يأتي بعده يسمى الحلية ومن ثم الحلوى.
المصدر: الرياض: فتح الرحمن يوسف -الشرق الأوسط