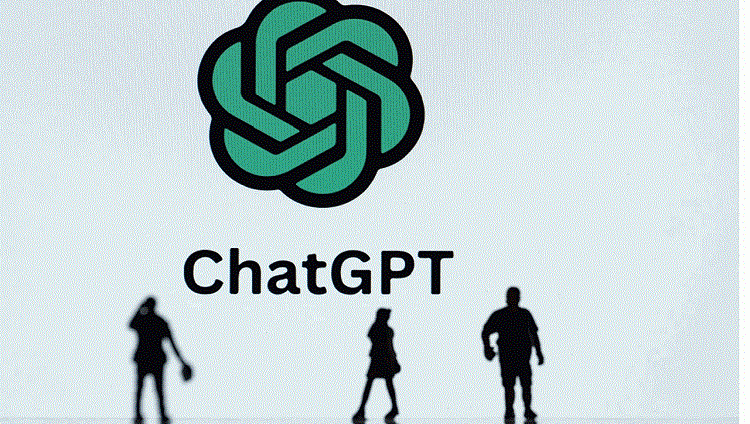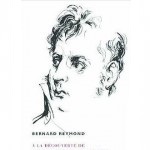

من سمع باسم هذا المفكر الألماني الكبير؟ ربما لا أحد، أو قل حفنة نادرة من الباحثين الاختصاصيين. ومع ذلك، فإن أهميته تقارن أحيانا بأهمية هيغل، أو على الأقل فيخته وشيلنغ وكبار ممثلي الفلسفة المثالية الألمانية. فمن هو هذا الفيلسوف يا ترى؟ هذا ما يجيبنا عنه البروفسور برنار ريمون أستاذ علم اللاهوت الديني في جامعة لوزان بسويسرا، وأحد المختصين المعدودين بفلسفة شليرماشير وتأثيرها الكبير على الفكر الديني والفلسفي المعاصر في أوروبا كلها، وليس فقط في العالم الجرماني.
ومنذ البداية، يقول لنا في كتابه «بحثا عن شليرماشير» إنه كان أحد كبار المصلحين الدينيين في ألمانيا في النصف الأول من القرن الـ19. وقد كان زميلا لهيغل في جامعة برلين، ويحظى باحترامه وتقديره رغم الاختلاف حول بعض المسائل الدينية أو الفلسفية، ثم يردف المؤلف قائلا:
ولد شليرماشير في مدينة بريسلو الألمانية عام 1768، ومات في برلين عام 1834. عن عمر يناهز السادسة والستين. وقد تربى تربية دينية تقية في البداية، وسوف يحمل في أعماقه الطابع الأخلاقي لهذه التربية طيلة حياته كلها. وبعد أن درس العلوم الدينية المسيحية في جامعة (لأهال) اشتغل مربيا للأطفال في إحدى العائلات الغنية الأرستقراطية. ومعلوم أن هذه العادة كانت سائدة في ألمانيا آنذاك. فهيغل نفسه اشتغل مربيا للأطفال في إحدى العائلات، لكي يكسب رزقه، ويستطيع إكمال دراساته الجامعية.
وكذلك فعل هولدرلين أيضا وآخرون كثيرون. وكانت تلك الوظيفة تمثل مرحلة إجبارية قبل الوصول إلى منصب جامعي، ومرتّب ثابت يضمن للمثقف عيشه.
وبعد ذلك، عُين شليرماشير أستاذا لعلم اللاهوت والفلسفة في جامعة «لاهال» التي تخرج فيها سابقا. ولكن غزو نابليون لألمانيا أجبره على العودة إلى برلين، حيث اشتغل مع الفيلسوف الكبير فيخته مساعدا له. وقد ساهم عندئذ مع هذا الفيلسوف في بلورة مبادئ القومية الألمانية، كرد فعل على القومية الفرنسية الغازية، لنتذكر كتاب فيخته الناري: «خطابات موجهة إلى الأمة الألمانية»! ومعلوم أنه ألهم قادة الفكر القومي العربي كزكي الأرسوزي وساطع الحصري وميشال عفلق.. وهزهم هزا. ولكن هل فهموه حقيقة؟ هذه مسألة أخرى.
ومعلوم أن فرنسا كانت قد أصبحت ذات رسالة كونية خالدة، بعد اندلاع الثورة الفرنسية. وقد أرادت تصدير هذه الثورة بكل مبادئها التنويرية إلى شتى أنحاء العالم حتى ولو بقوة السلاح، كما فعل نابليون بونابرت. ولكن ذلك أيقظ عند أبناء الشعوب الأخرى العاطفة القومية المضادة. فالألمان لا يقلون أهمية عن الفرنسيين، بل إنهم يتفوقون عليهم في مجالات كثيرة. وقد أخذوا يشعرون بأنهم أمة واحدة من حيث اللغة والتاريخ والجغرافيا والتراث المشترك. ولذلك راحوا يفكرون بتوحيد أنفسهم منذ ذلك الوقت. وعندما تأسست جامعة برلين عام 1810 عينوا شليرماشير أستاذا لعلم اللاهوت المسيحي. وقد ظل يشغل هذا المنصب حتى نهاية حياته عام 1834. وفي الوقت ذاته، راح يعطي دروسا حرة عن تاريخ الفلسفة. وهكذا جمع شليرماشير منذ البداية بين تعليم الدين وتعليم الفلسفة، وأصبح أكبر مصلح ديني في ألمانيا بعد مارتن لوثر.
ثم يقول لنا المؤلف ما فحواه: لقد ساهم هذا المفكر الكبير في مصالحة الدين المسيحي مع الحداثة، أي في انفتاح كليات الشريعة المسيحية على الفلسفة والعلم الحديث. ومعلوم أنها كانت منغلقة على كل ذلك من قبل. وكانت تدرس الدين على طريقة القرون الوسطى الأصولية الظلامية. وبالتالي، فإن العمل الذي قام به فريديريك شليرماشير كان مهما جدا. لقد ساهم في بلورة التفسير الليبرالي أو العقلاني للدين المسيحي، لكي يحل محل التفسير التقليدي المتحنط، أي التفسير الطائفي والمذهبي القديم. وهي المهمة الجليلة المطروحة بكل إلحاح على كبار المثقفين العرب والمسلمين اليوم.
ومعلوم أن ألمانيا كانت منقسمة آنذاك مذهبيا إلى قسمين كبيرين؛ كاثوليكي وبروتستانتي، مع بعض الغلبة العددية للبروتستانتيين. وهذا الانقسام أشعل الأحقاد الطائفية في ألمانيا، ومنعها من توحيد نفسها أو قل عرقل عملية التوحيد.
ولذلك نهض المفكرون التنويريون الألمان من أجل مكافحة التفسير الطائفي والمتعصب للدين وإحلال التفسير الليبرالي والعقلاني محله. وهو التفسير الوحيد القادر على محاربة الطائفية والانقسامات الداخلية، وبالتالي تسهيل تحقيق الوحدة القومية الألمانية. ومعلوم أن العرب أيضا لن يتوحدوا قبل إنجاز هذه المهمة الشائكة. ولذلك فشلت كل مشاريع الوحدة العربية سابقا، بل وحتى القطر الصغير الواحد أصبح مهددا بسبب هذه النعرات الطائفية والمذهبية التي تشتعل اشتعالا. ولكن ماذا يفعل المثقفون العرب؟ هل يقومون بواجبهم كما فعل فلاسفة ألمانيا سابقا؟ أبدا، لا. إنهم لا يعرفون كيفية طرح الإشكالية الطائفية، فما بالك بحلها؟ كارثة!
لكن لنواصل مع المؤلفة قصة هذا المفكر الألماني الذي جمع في شخصه بين أنوار الدين وأنوار الفلسفة، يقول: في عام 1811 فتحت أكاديمية العلوم في برلين أبوابها لهذا المفكر الفذ الذي ذاعت شهرته بفضل أبحاثه العلمية الجادة. وفي عام 1817 ترأس الاجتماع الكبير الهادف إلى تحقيق التقارب والمصالحة بين المذاهب المسيحية المتعادية، التي يكفر بعضها بعضا. ولم يكن الانقسام حاصلا بين البروتستانتيين والكاثوليكيين فقط، وإنما أيضا داخل المذهب البروتستانتي نفسه! فقد كان ينقسم إلى قسمين كبيرين؛ قسم تابع لكالفن، وقسم تابع للوثر. وقد حاول شليرماشير إقامة التقارب بينهما. ولكنه لاقى مقاومة عنيفة من طرف الرجعيين المتعصبين في كلتا الجهتين، كما يحصل عادة. فكل طرف أصولي يرى نفسه على حق والآخر على ضلال. والأصوليون المتطرفون لا يؤمنون بالحوار وإنما بالضرب والإكراه القسري فقط. الآية القرآنية الكريمة: «لا إكراه في الدين»، لم يسمعوا بها حتى الآن. وربما عدوها منسوخة! يضاف إلى ذلك أن السلطة البروسية وقفت ضده، لأنها رأت في أفكاره الليبرالية خطرا على وحدة العقيدة المقدسة للمذهب البروتستانتي. ولكنه رغم كل ذلك راح يمارس تأثيرا كبيرا على حركة الأفكار في عصره. وربما لم يكن يضاهيه في هذا المجال إلا هيغل.
ثم يردف المؤلف قائلا: إن شليرماشير يعترف بتأثير أفلاطون عليه، ويقول إنه المفكر الأكبر الذي حسم مساره الفكري والفلسفي. ولكنه يعترف أيضا بتأثره بأفكار سبينوزا، ولايبنتز، وكانط، وفيخته، وشيلنغ، إلخ.. لاحظوا.. رجل دين ولا همَّ له إلا التمعق في كتب الفلسفة! أما رجال الدين عندنا، ففي حياتهم كلها لم يفتحوا كتابا في الفلسفة. معاذ الله! كيف يمكن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها وتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم؟ على أي حال، فقد كان أول كتاب نشره بعنوان: «عن الدين.. خطاب موجه إلى الأشخاص المثقفين من بين مزدريه أو اللامبالين به»، وهو أهم كتبه، بحسب رأي البعض، وفيه يعلن اتفاقه مع كانط الذي حاول المصالحة بين الفلسفة والإيمان في كتابه الشهير: «الدين ضمن حدود العقل فقط».
فقد رفض شليرماشير على أثر كانط أن تكون للعقائد الدينية أي يقينية علمية بالمعنى البرهاني التجريبي للكلمة. وكان يقصد بذلك أنها قائمة على الاعتقاد الإيماني الذاتي الحميمي بالدرجة الأولى. ولكنه كان يعتقد بأنه يوجد في أعماق الإنسان ميل عاطفي أو روحي لتحقيق وحدة الأنا مع اللانهائي أو لانصهار الأنا في اللانهائيات. فالإنسان مشكَّل من المعرفة والممارسة، ولكن توحيد كل فعالياته لا يجري إلا عن طريق العامل العاطفي الروحي الذي يشكل جوهر الدين.
ثم يردف البروفسور برنار ريمون قائلا: وبالتالي فإن شليرماشير كان يفرق بين جوهر الدين وقشوره، بين العمق والسطح، بين ما هو أساسي وما هو شكلاني خارجي تتعلق به العامة عادة، ثم يرى هذا الفيلسوف أن الإنسان الديني أو الروحاني غير مقطوع عن التعالي اللانهائي، على عكس الإنسان المادي أو الدنيوي المحض. وينتج عن ذلك أن الحداثة الحقيقية لا تعني القضاء على الدين، وإنما إعادة فهمه بشكل جديد. فالإنسان الديني بالمعنى العميق للكلمة، أي الروحاني، يشعر بشكل عفوي مباشر أن المحدود يعثر على مبرر وجوده في اللامحدود، أي في اللانهائي. وعلى هذا النحو يتعاطف مع الروح الكونية، أي مع الروح الإلهية. فالله وحده هو اللانهائي، وهو وحده المطلق اللامحدود، على عكس الإنسان. ويرى شليرماشير أن الدين مرتبط بالعلم والممارسة العملية، حتى وإن لم يكن متطابقا معهما. فالعلم يطوّر معرفتنا باللانهائي وبالتالي يفتح الأفق على الدين بالمعنى العميق والجوهري للكلمة. والممارسة الفنية والأخلاقية لا معنى لها إلا بالقياس إلى الفعالية الكونية التي تندرج فيها. والخلود الحقيقي للإنسان يكمن في شعوره بالانصهار داخل اللانهائي والأبدي في وحدة واحدة. ما عدا ذلك فلا يوجد أي خلود مضمون.
ثم يردف شليرماشير قائلا: وبالتالي فإن جميع الأديان المعروفة ليست إلا عبارة عن صيغ فردية أو تنويعات خصوصية عن صيغة الدين الكوني الشامل. وهي أشكال ضرورية، لأن الدين الطبيعي أو العقلاني للفلاسفة ليس إلا تصورا تجريديا لا يفهمه عامة الشعب. كل الأديان هي عبارة عن تجليات للروح، وإن بدرجات متفاوتة. إنها تربط بين الكائن الفردي من جهة، والكائن اللانهائي من جهة أخرى. بمعنى آخر فإنها تربط بين الإنسان والله. وهكذا لا يعود الإنسان يشعر بأنه وحيد في هذا العالم، ولا يعود الموت يرعبه، لأنه أصبح خالدا من خلال انصهاره بتاريخ البشرية كلها، وباللانهائيات التي لا حدود لها، وبمطلق الله في نهاية المطاف، ثم ألف شليرماشير كتابا آخر بعنوان: «مونولوجات: أي حوارات داخلية مع الذات». وقد استفاد فيه من كتاب فيخته: «غاية الإنسان»، أي مصيره ومقصده النهائي. ولكن فيخته اتهم بالإلحاد، على عكس شليرماشير الذي كان في أعماقه رجلا مؤمنا حقا. مهما يكن من أمر فإن الحوار بين الفلاسفة الدنيويين والفلاسفة المتدينين كان شيئا ضروريا ومهما وخصبا جدا. كان مفيدا لكلا الطرفين. وقد عبّر شليرماشير في هذا الكتاب عن الفكرة التالية: إن غاية كل إنسان هي أن يجسد البشرية كلها في شخصه. المقصود بذلك أن الإنسان يمثل الروح الكونية، وإن بطريقة خاصة تتناسب مع شخصيته وفرادته واختلافه عن غيره. وهذا يشبه ما قاله الشاعر العربي يوما ما:
وتزعم أنك جرم صغير
وفيك انطوى العالم الأكبر
وبالتالي فالإنسان لا يموت ضمن مقياس أنه مخلَّد عن طريق استمرارية البشرية ذاتها، وعن طريق انصهاره بالروح الكونية للكون، عن طريق فنائه في مطلق الله الذي لا يحول ولا يزول.
ولكن فردية الإنسان أو تمايزه عن غيره لا ينبغي أن تقضي على فكرة التواصل والتضامن بين البشر. على العكس فإن الحب الذي يربط بين الكائنات هو الشرط الضروري لاكتمال شخصية الفرد، أي فرد كان. وبالتالي فالحب هو جوهر الدين. وإذا كان الأمر غير ذلك، فهذا يعني أن الناس فهموا الدين بشكل خاطئ، أو سطحي، خارجي، شكلاني، فارغ. وينتج عن ذلك أن المتدينين الذين يدعون للتعصب هم خونة لجوهر الدين ومبادئه الحقيقية. وينطبق ذلك على الأصوليين المسيحيين إبان محاكم التفتيش والحروب الصليبية، كما ينطبق على الأصوليين الإسلامويين اليوم.
فالأديان السماوية الكبرى دعتنا إلى محبة الآخر أو الجار والاهتمام به وبمصلحته مثلما نهتم بأنفسنا، كما دعتنا للرفق بالضعيف والفقير وابن السبيل والإحسان عليه. وبالتالي فأي شخص يفهم الدين على أساس أنه حقد على الآخرين أو تكفير لهم، ناهيك عن الدعوة إلى قتلهم وتصفيتهم جسديا، هو شخص ضال، مضلل، خارج على جوهر الدين ومبادئه السامية.
بهذا المعنى، فإن شليرماشير كان أحد كبار فلاسفة التنوير الأوروبي، أو أحد كبار رجال الدين المستنيرين. لقد ربط بين العقل والنقل، أو بين الدين والفلسفة، وجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة والسكينة لأنه أنهى ذلك الصراع المدمر بين العلم والإيمان. لم يعد العلم في جهة والإيمان في جهة أخرى، وإنما أصبحا متكاملين رغم خصوصية كل منهما. أصبحا منصهرين مع بعضهما في بوتقة واحدة.
وعلى هذا النحو، تقدم العلم في أوروبا، وازدادت اكتشافاته، في الوقت الذي تقدم فيه الإيمان واستنار وأصبح عقلانيا، ليبراليا، متسامحا. وبالتالي فإن الحداثة لا تعني الكفر والإلحاد بالضرورة كما يتوهم بعضهم، وإنما تعني الفهم الجديد للدين، أي الفهم المستنير القائم على البصر والبصيرة لا على الجهل والتسليم والتواكل والتخلف.
هكذا انتقلت أوروبا من إيمان القرون الوسطى إلى إيمان العصور الحديثة، أي من الإيمان الطائفي والمذهبي الضيق إلى الإيمان المتسامح، الحر، الواسع الذي يشمل جميع خلق الله، ولا يستبعد أحدا من جنته، بشرط أن يكون إنسانا صالحا، مستقيما، نزيها، محبا للخير العام وكأنه خيره الشخصي. على هذا النحو استطاع فريديريك شيلرماشير أن يفتح للشعب الألماني آفاقا واسعة وينتقل به من حالة الاقتتال المذهبي والطائفي إلى حالة الوحدة القومية والروحية والفلسفية. وكفاه ذلك فخرا!
باريس: هاشم صالح – الشرق الأوسط